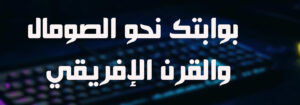قديما كان الموت يستدعي الصمت والوقار. مجرد انسحاب الجسد من الدنيا كان كافيا ليخفض الأحياء أصواتهم، ويكتفوا بالدعاء. أما اليوم، فقد صار الموت عرضا يوميا على شاشات الهواتف، و«ترندا» يتسابق عليه من يبحث عن لفتة عابرة أو حضور سريع. صورة باهتة من أرشيف قديم تتحول إلى بطاقة انتماء، وتعليق ساذج من نوع «الصديق العزيز» أو «الأسطورة» يُرفع إلى مقام البيان الرسمي، مع أن الراحل لم يمنح صاحبه في حياته أكثر من مصافحة باردة أو ابتسامة عابرة.
صارت المنصات محاكم هزلية: «إعجاب» بمثابة حكم ابتدائي، و«مشاركة» كأنها محكمة استئناف، و«تداول» هو النقض النهائي الذي لا رجعة فيه. وفي هذه المحاكم يموت الإنسان مرتين: مرة حين يغيب جسده، ومرة حين يُسلَّم إلى جمهور يضغط على الأزرار أكثر مما يقرأ الكلمات. هكذا تُسحق سيرة كاملة تحت أقدام التفاهة، ويُختزل عمر من التجارب واللحظات في بضع تعليقات ركيكة ، وصور لا تصمد أمام أول تحديث في خوارزمية النسيان.
الموت لا يليق به أن يتحول إلى سلعة استهلاكية، ولا أن تختصر الجنازة في «هاشتاغ» يلهث وراءه طلاب المتابعين. والحد الأدنى من الوفاء أن يُترك للراحل وقاره الأخير، وأن تُصان سيرته من الابتذال، بدل أن تُودع إلى صخب عابر وتعليقات مستعجلة. فالموت، في جوهره، ليس مناسبة لتسويق الذات، ولا فرصة لزيادة الأرقام، بل لحظة مواجهة صامتة مع هشاشتنا جميعا، وفرصة أخيرة لإثبات أن الكرامة يمكن أن تبقى حتى بعد أن يغادر صاحبها الحياة.
إلى أين يمضي مجتمع يشيّع موتاه على المنصات، ويترك لهم إرثا من «اللايكات» أكثر مما يترك من تراتيل الرحمة؟ وأي قسوة أبشع من أن يتحول الرثاء إلى وسيلة ظهور، والجنازة إلى وسم يتزاحم عليه الباحثون عن الضوء، في عالم لا يعرف الصمت، ولا يحفظ للرحيل ما يليق به من خشوع؟
الموت في زمن الوسوم