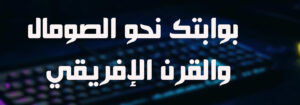على امتداد ما يقارب عشرة قرون، اضطلع الصوماليون — أو، إذا شئت قل، البرابرة، الجباريت، أو الزيالعة —، برفقة مسلمي القرن الإفريقي، بدور تاريخي بالغ الأهمية في حماية البحر الأحمر والدفاع عن بوابته الجنوبية، من خلال ما عُرف بالممالك الطراز الإسلامية، وذلك في كثير من الأحيان دون أي سند فعلي أو دعم منظم من العالمين العربي أو الإسلامي.
وقد أسّست معظم هذه الممالك قبائل ذات أصول قرشية وافدة، اندمجت اندماجًا كاملًا مع السكان الأصليين، حتى تغيّرت ألوانها وألسنتها بفعل المعايشة الطويلة، وحُسن السيرة، وكثرة المصاهرة مع المجتمعات المحلية زواجًا وتزويجًا.
وبمرور الزمن، غدت هذه الجماعات آفرو آسوية جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، فتشكّلت هوية إسلامية جامعة، ذات ثقافة إسلامية، متماسكة اجتماعيًا ومتجذّرة تاريخيًا.
ومع استقرار هذه المجتمعات، تشكّلت في بداياتها كيانات إدارية ذات طابع عشائري، اتّسمت علاقاتها أحيانًا بالتجاور والتنافس، وأحيانًا أخرى بالصراع والاحتراب.
ومع مرور الزمن، تطوّرت هذه الكيانات العشائرية تدريجيًا إلى سلطانات وممالك معروفة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، الموافقين للقرنين السابع والثامن الهجريين.
وفي بداياتها، كانت بعض هذه السلطنات تؤدي إتاوات لمملكة الحبشة، غير أنّ تصاعد الضغوط الحبشية ومحاولات التمدد على حساب نفوذ تلك الممالك حوّل العلاقة من تبعية شكلية إلى صراع مفتوح. وعندما استشعرت هذه السلطنات خطرًا وجوديًا يهدد استقلالها وكيانها، خاضت ضد الأحباش صراعًا بلا هوادة، دفاعًا عن سيادتها وحفاظًا على بقائها.
وقد أطلق المؤرخون على هذه الكيانات لاحقًا اسم “الممالك الطراز الإسلامية السبع”، وهي: إيفات (عِفَت)، هدية، داراو، بالي، أربيني، شرخا، ودارة، لامتدادها المتواصل على ضفتي البحر الأحمر من جهة القرن الإفريقي.
وبمحاذاة هذه السلطنة، وعلى امتداد الساحل الجنوبي، برزت سلطنة أجوران، التي اتخذت من مقديشو مقرًا لها.
وقد وصفها ابن بطوطة بقوله: «وبلادهم صحراء مسيرة شهرين، أولها زيلع وآخرها مقدشو»، في إشارة واضحة إلى سعة المجال الجغرافي الذي خضع لسلطانهم، ودلالة على امتداد نفوذ القومية الصومالية وسيطرتها على معظم سواحل القرن الإفريقي في تلك الحقبة.
وبعد سقوط إيفات وشقيقاتها على يد الأحباش، نهضت سلطنة عدل، لتبلغ المواجهة ذروتها في القرن الإفريقي مع بروز القائد المجاهد الإمام أحمد بن إبراهيم الغُرَيّ، الذي ألحق هزائم قاسية بالقوات الحبشية والبرتغالية، وامتدت حملاته إلى كسلا، ووصلت إلى تخوم موقع أديس أبابا الحالي، في واحدة من أعنف مراحل الصراع على هوية المنطقة ومصيرها.
عموماً، اضطلعت هذه الممالك بدور محوري كحزام دفاعي وتجاري وثقافي بالغ الأثر في التفاعل الإفريقي–الآسيوي، وهو ما أسهم في إبعاد النفوذ الحبشي سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا عن السواحل، وحصره في المرتفعات الداخلية، ولا سيما مناطق أمهرة وتِغراي، التي كانت عاصمتها التاريخية أكسوم. وقد شهدت المنطقة في ظل هذه الممالك ازدهارًا اقتصاديًا وثقافيًا لافتًا، وكان لها دور محوري في نشر الإسلام وترسيخ حضوره واستمراره، بما أسّس لواقع حضاري متماسك على امتداد القرن الإفريقي.
غير أن هذه الممالك دخلت في صراع طويل ومرير مع الأحباش، الذين حظوا بدعمٍ بيزنطي أولًا، وبرتغالي ثانيًا، وأوروبي ثالثًا عبر قرون عديدة، ليصبح الصراع في القرن الإفريقي مواجهة عالمية بين المسيحية والإسلام. ومع قدوم الاستعمار الغربي البريطاني والفرنسي والإيطالي، ازدادت حِدّة الصراع وضراوته، في إطار مواجهة دينية وسياسية هدفت إلى السيطرة على البحر الأحمر، واتخاذه بوابة لإضعاف العالم الإسلامي في الشام ومصر وجزيرة العرب.
وقد تواطأت القوى الغربية مع الحبشة، متغاضية عن ممارساتها القمعية في وقائع عدة، وهو ما توج بتقسيم الأراضي الصومالية إلى خمسة أجزاء، بقصد إضعافها وطمس دورها الديني، وتقويض وحدتها الثقافية والحضارية. وعقب الاستقلال، أصبح الصومال دولةً موحدة من جزأين، الشمالي والجنوب، تحت اسم الصومال الحديثة، ذات السيادة المعترف بها عالميًا عام 1960، والتي سقطت عام 1990. ومع ذلك، هناك اليوم محاولات لإعادة تقسيمها مجددًا، نتيجة إهمال الدول الإسلامية والعربية أو تورط بعضهم، ما جعل الصومال منسية لأكثر من ثلاثين سنة، وتلعب بها أيدي القوى الغادرة والأعداء.
وقد وصل الحال اليوم إلى حدّ تدخل الكيان الصهيوني ووكلائه، ما ينذر بعودة التنافس الدولي والإقليمي إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، كما كان في القرون الوسطى حين كان الصوماليون وحدهم يقفون أمام نار الصراع باسم الممالك ذات الطراز الإسلامي، وباسم سلطنة عدل وسلطنة أجوران، وحتى باسم الدولة الصومالية الحديثة بعد الاستقلال، التي خاضت صراعًا مع الأحباش في هذا الميدان دون دعم يُذكر من أشقائها العرب أو الدول الإسلامية.
وفي هذا السياق، تتكشف نتائج الإهمال التاريخي بوضوح، مما جعل الخطر يشمل عموم العالم العربي والإسلامي، لا سيما بعد إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بأقاليم شمال غرب البلاد الانفصالية بوصفها دولة مستقلة. وما يجري اليوم ليس سوى حلقة جديدة من صراع قديم بأدوات معاصرة، في انتظار وعي تاريخي يعيد ترتيب الأولويات واستدراك حجم التحولات قبل أن تتسع دوائر الخطر.
ويمكن قراءة هذا الخطر في ثلاث دوائر متداخلة:
الدائرة الأولى: الأقرب والأشد تعرضًا للاكتواء لنار هذه الفتنة، وهي إدارة شمال غرب البلاد الانفصالية وسكانها الذين استقبلوا الاعتراف المزعوم من الكيان الصهيوني بفرحة دون إدراك لمخاطر هذا المشروع الدينية والدنيوية، حيث ستكون الساحة الأولى لانعكاسات هذا التحول، بما قد يجعلهم أول المنكوبين بالنار التي أوقدوها لأنفسهم.
الدائرة الثانية: تشمل عموم القومية العربية وتركيا، وفي مقدمتها مصر ودول الخليج واليمن، نظرًا لموقعها الجغرافي وثقلها التاريخي، ودورها المحوري في أمن البحر الأحمر واستقراره الاستراتيجي، حيث سيمتد تأثير هذه الفتنة إليهم بشكل غير مباشر، بما يستدعي الحيطة والجاهزية لمنع توسع رقعتها.
الدائرة الثالثة: تشمل القومية الصومالية في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، وبصفة أخص ما تبقّى من جمهورية الصومال الفيدرالية.
وسيضطر الصوماليون في الداخل بشكل خاص لتحمّل تبعات هذا الخلل الاستراتيجي على المديين القريب والبعيد، نتيجة سوء إدارة ساستهم وتعصبهم للقبلية على حساب الدين والوطن، سياسيًا وأمنيًا ووجوديًا. فاعتراف الكيان الصهيوني بإقليم شمال غرب البلاد كدولة مستقلة يفتح الباب أمام موجة جديدة من الأطماع الجغرافية في هذا البلد المسلم وثرواته الهائلة، ويهدد وحدته واستقراره، بما قد يذكّر بمأساة الأندلس، إذا لم تتدخل الدول الإقليمية الفاعلة مثل مصر وتركيا والسعودية ببناء دولة قوية وجيش وطني صومالي قوي قادر على صون السيادة وحماية وجود الدولة الموحدة المستقلة.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي