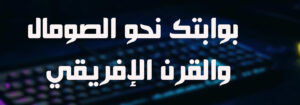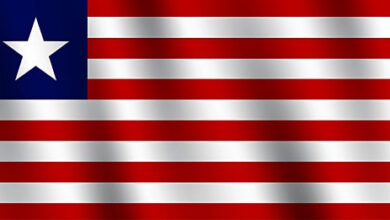شاهدت فيلم Scent of a Woman بعد صدوره بعامين تقريبا. كنت حينها غارقا في عشق الفن السابع، أتنقل بين أفلامه كما لو أنني أفتش عن حياة اخرى، اكثر صفاء وصدقا. لا أدري إن كنت أحب السينما لأنني أبحث عن الحكايات، أم لأنني أبحث عن نفسي داخلها. لكن هذا الفيلم لم يكن مجرد عمل سينمائي ولا مشاهد متقنة ولا تمثيلا بارعا فحسب، بل كان شيئا آخر. شيئا يشبه الاعتراف.
لم أتعاطف مع العقيد فرانك سليد لأنه كفيف، أو لأنه جريح النفس، بل لأنه، ببساطة، تمسك بعناده ولم يتنازل عنه. كنت أتابعه كما لو أنني أراقب رجلا يشق الظلام بقبضته. آل باتشينو لم يكن يمثل، بل كان يجسد روح الانسان حين ينهض واقفا رغم الخذلان. خطواته، صمته، صوته المرهق، وحتى عكازه الذي كان يسند به جسده المتعب كل ذلك بدا لي وكأنه ينطق بشيء في داخلي، شيء لم أستطع أن أضع له اسما، لكنه كان حقيقيا تماما.
في مشهد التانغو، حين طلب من فتاة لا يعرفها أن ترقص معه، لم أر مجرد رقصة. كانت الحياة نفسها تنهض معه على خشبة ضيقة بين الطاولات. تابعت المشهد بحبس أنفاس، كأنني أخشى أن يسقط، أو تتعثر قدماه. ثم أدركت أنني أنا الذي كنت أخاف السقوط، لا هو.
وفي مشهد قيادة الفيراري، ظننت أن الامر سينتهي بكارثة. رجل أعمى يقود سيارة سريعة! لكن المفارقة أنني لم أشاهد تهورا، بل رأيت رجلا يعود إلى الحياة بشراسة طفل جائع. فهمت حينها أن الجرأة ليست غباء، بل قد تكون — في بعض اللحظات — شكلا من اشكال الايمان.
ثم جاء خطاب المدرسة؛ لحظة مواجهة بين الصمت والحقيقة، بين ما يفترض أن يقال، وما يجب أن يقال. الشاب تشارلي، الذي بدا في البداية مجرد ظل للعقيد، تحول إلى مرآة. مرآتي. مرآة كل من وقف يوما في وجه سلطة ما: سلطة الاب، المدرسة، المؤسسة، الواقع. وحين انبرى العقيد مدافعا عنه، شعرت أن الصوت الذي يتكلم ليس صوته وحده، بل صوتي أنا، وصوت كل من قال لا حين كان الاسهل أن يقول نعم.
مارتن بريست لم يصنع فيلما، بل نصب مرآة كبيرة في وجه كل مشاهد، وقال له: تجرأ وانظر.
وهكذا وجدت نفسي، اكثر من مرة، جالسا في الظلام، أتابع مشهدا بسيطا: رجل وحيد يحدق في مرآة. لا كلمات، لا مؤثرات، لا حوارات. فقط مرآة، ورجل، وضوء خافت. لكن هذا المشهد وحده كان كافيا ليشعل شيئا داخلي. شعرت أنه ينظر إلي، لا إلى نفسه.
ما فعله آل باتشينو هنا لا تشرحه منطقية الجوائز، ولا تفيه لغة النقاد. لم تكن هذه شخصية محكمة الصياغة، بل حياة أعيد خلقها، بكل وجعها وهشاشتها وتمردها. كل نظرة، كل تنهيدة، كل التفاتة، بعكاز أو دونه، كانت تشبهنا. نحن الذين نخسر ولا ننسحب، نحزن ولا نكفر، ونحلم رغم كل ما فقدناه.
أفلام كثيرة مرت في حياتي. بعضها اختفى من ذاكرتي اسما وسببا لكن هذا الفيلم، كلما أعدته، لم أبحث فيه عن الجديد، بل عن ذلك الشاب الذي كان يجلس في الظلمة، فتعلم أن النور لا يأتي دائما من الخارج، بل ربما كان يسكنه، ينتظر فقط أن يتوقف عن الخوف.