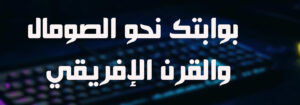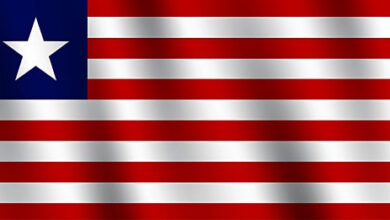في حياة إرنست همنغواي كثير من البنادق، لكن أشهرها كانت الأخيرة. رجل بدأت حياته على جبهة الحرب، وانتهت عند ضغط زناد بندقيته في المنزل. بين الأولى والأخيرة كتب ما يكفي ليجعل النقاد يتقاتلون على تصنيفه، والقراء يترددون في تصديقه.
لم يكن يحب الحرب، لكنه ذهب إليها أكثر من مرة. لا ليموت، بل ليعرف لماذا يموت الناس. جرح، وكتب، وادعى أن البطولة وهم. ثم عاد ليكتب عن الأوهام بحرفية الأبطال.
في باريس، حيث تجتمع الخمرة مع اللغة الفرنسية، التقى بجويس وباوند وستاين. جلس معهم، لكنه لم يجلس إليهم. كان أقرب إلى ذئب وحيد، يؤمن أن الجملة الجيدة يجب أن تنزل على الورق مثل رصاصة: مباشرة، وباردة، وبدون اعتذار.
كتب عن كل شيء تقريبا: عن العجوز الذي طارد سمكة في “العجوز والبحر”، عن الجندي الذي خسر الحب في “وداعا للسلاح” ، عن الثائر الذي واجه الموت في “لمن تقرع الأجراس”، وعن التائهين في زمن ضائع في “الشمس تشرق أيضا”. ولم يكن أيّ من هؤلاء سوى وجه من وجوهه. لم تكن شخصياته تنطق باسمه، لكنها كانت تمشي على ظله.
كان يؤمن أن الرجل يمكن أن يدمر، لكنه لا يهزم. عبارة أنيقة، تصلح للتعزية في جنازة، لكنها كانت طريقته في الاعتراف بأن الحياة ليست نصرا موعودا، بل عبورا هشا وسط العثرات والمفاجآت الصغيرة.
أحب النساء، وتزوج أربعا، وخاف منهن جميعا. وكان يكتب عن الحب كمن يعتذر عن اقترافه. قال مرة: “كل من تحبه، تفقده في النهاية”. وربما كان يقصد الكاتبة، أو العشيقة، أو القارئ، أو نفسه.
نوبل؟ حصل عليها. لم يرقص احتفالا، ولم يذرف دمعة فرح. اكتفى بجملة مقتضبة، كعادته، وقال: أعطوني إياها لأنني لم أمت. ثم عاد إلى صمته، وكأن شيئا لم يحدث. ما زال هناك من يقول إن الجائزة جاءت متأخرة. وربما الأصح أنها جاءت لرجل كان يكتب للموتى.
وفي صباح يشبه مشهده الأخير، أطلق النار على رأسه، وخرج من الرواية. لم يترك خطابا. ترك كتبه. وهي خطابات أطول، وأصدق، وأكثر مرارة.
الجميل في همنغواي أنه لم يكتب ليربي جمهورا، بل ليربي نفسه. لم يكتب من أجل المجد، بل من أجل النجاة. ونجا، ربما، لكنه نجا كثيرا، إلى الحد الذي لم يتحمله في النهاية.
وبعد كل هذه السنوات، لا يزال اسمه حاضرا في كل سطر موجز، في كل وصف صادق، في كل كاتب جلس في العتمة، وواجهها بالحبر، بدلا من البكاء.