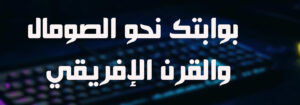لا يمكن فهم المشهد السياسي في الصومال من خلال ما يُقال على الشاشات وحدها، ولا من خلال المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مهما بلغت حدّتها أو اتسع انتشارها. فالخطاب العلني، خاصة خطاب المعارضة، كثيرًا ما يُبنى على المبالغة، والتصعيد اللفظي، وإظهار القطيعة التامة مع السلطة الحاكمة، حتى يظن المواطن البسيط أن البلاد مقبلة على مواجهة سياسية مفتوحة لا رجعة فيها. غير أن التجربة الصومالية، ومعها تجارب كثيرة في دول ما بعد النزاعات، تؤكد أن السياسة لا تُدار بهذه البساطة.
ففي الوقت الذي يهاجم فيه المعارضون الحكّام بأقسى العبارات، ويتهمونهم بالفشل وسوء الإدارة، بل وأحيانًا بالخيانة الوطنية، تستمر قنوات الاتصال مفتوحة في الخفاء. لقاءات غير معلنة، وسطاء، رسائل متبادلة، وتفاهمات مرحلية، كلّها تجري بعيدًا عن أعين الرأي العام. وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: خطاب ناري في العلن، وبراغماتية باردة في الخفاء.
هذه الازدواجية ليست سلوكًا طارئًا، بل أصبحت جزءًا من الثقافة السياسية السائدة. فالسياسي الصومالي يخاطب جمهورًا متعدّد الطبقات والولاءات: شعبًا أنهكته الأزمات، عشيرة تنتظر المكاسب، حلفاء يبحثون عن ضمانات، ومجتمعًا دوليًا يراقب ويقيّم. ولكل جمهور لغته ورسائله الخاصة.
في هذا الإطار، يتحول الخطاب المعارض إلى أداة تعبئة لا أداة تفسير. لا يُراد منه دائمًا شرح البدائل أو تقديم حلول تفصيلية، بل يُراد له أن يُحدث صدى، أن يرفع منسوب الغضب، وأن يضع الحكومة تحت ضغط شعبي متواصل. أما الحلول، فتُؤجَّل إلى طاولة التفاوض، حيث تُدار السياسة بلغة الأرقام، والمواقع، والتوازنات.
ولا يمكن فصل هذا السلوك عن طبيعة الدولة الصومالية نفسها. فالدولة التي ما زالت في طور إعادة البناء، والتي تعاني من هشاشة مؤسساتها، وازدواجية السلطة بين المركز والأقاليم، وتداخل النفوذ العشائري مع القرار السياسي، لا تسمح بخطاب سياسي مستقر وواضح. كل موقف محسوب، وكل كلمة موجهة بعناية، ليس فقط للخصم السياسي، بل لبنية اجتماعية معقّدة تتأثر بالكلمة أكثر مما تتأثر بالفعل أحيانًا.
لكن الخطر الحقيقي يظهر حين يصبح هذا الأسلوب هو القاعدة لا الاستثناء. حين يتعوّد المواطن على سماع خطاب غاضب لا يتبعه تغيير، ووعود كبيرة لا تُترجم إلى سياسات، يبدأ الشكّ بالتسلل إلى الوعي الجمعي. يفقد الناس الثقة ليس فقط في الحكومة، بل في المعارضة ذاتها. ويترسخ شعور عام بأن السياسة مجرّد صراع نخب، تُستخدم فيه الجماهير وقودًا للضغط لا شركاء في القرار.
وسائل التواصل الاجتماعي عمّقت هذا المأزق. فهي لا تكافئ الخطاب المتزن، ولا تمنح مساحة كافية للتحليل العميق، بل تفضّل الصدمة، والاختصار، واللغة الحادة. وهكذا، يجد السياسي نفسه محاصرًا بمنطق “التفاعل” لا بمنطق “المسؤولية”. كلما ارتفعت نبرة الاتهام، زاد الانتشار، وكلما اشتد الهجوم، كسب الخطاب جمهورًا أوسع، ولو على حساب الحقيقة أو المصلحة العامة.
في ظل هذا الواقع، تصبح المعارضة أمام اختبار أخلاقي وسياسي حقيقي: هل دورها فقط إسقاط الحكومة أو إضعافها إعلاميًا؟ أم أن دورها الأعمق هو تقديم بديل واقعي، قابل للتطبيق، ويحفظ ما تبقى من استقرار؟ فالمعارضة التي تكتفي بالصراخ دون رؤية، لا تختلف كثيرًا عن سلطة تُدير البلاد بلا مساءلة.
كذلك، لا يمكن إعفاء الحكومة من مسؤوليتها. فالتعامل مع المعارضة باعتبارها عدوًا دائمًا، أو التقليل من شأن غضب الشارع، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات بدل حلّها، كلّها ممارسات تفتح الباب أمام تصعيد الخطاب، وتغذّي حالة الاستقطاب. الدولة القوية لا تخشى النقد، بل تنظّمه وتستفيد منه.
إن ما يحتاجه الصومال اليوم ليس إسكات الأصوات، ولا إطلاقها بلا ضوابط، بل إعادة تعريف العلاقة بين الخطاب السياسي والمصلحة الوطنية. خطاب يعترف بالاختلاف دون تخوين، وينتقد دون تهويل، ويصارح الشعب بحقيقة التعقيدات بدل بيع أوهام سهلة.
وفي قلب كل ذلك، يبقى وعي المواطن هو خط الدفاع الأول. فالمواطن الذي يدرك أن السياسة ليست ما يُقال فقط، بل ما يُفعل، هو القادر على كسر هذه الدائرة. حين يسأل عن البرامج لا الشعارات، وعن النتائج لا النوايا، يصبح السياسي—حاكمًا كان أو معارضًا—مضطرًا إلى الارتقاء بخطابه وسلوكه.
وفي الختام، قد تستمر المعارك الكلامية، وقد تبقى الشاشات مسرحًا للتصعيد، لكن مستقبل الصومال لن يُحدَّد بنبرة الصوت، بل بصدق المواقف، ونضج النخب، ووعي شعب أدرك أخيرًا أن السياسة، مهما لبست من أقنعة، لا يمكن أن تنجح طويلًا دون مصارحة حقيقية ومسؤولية مشتركة.
لغة السياسة: خصومة بلا فراق