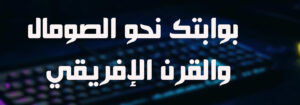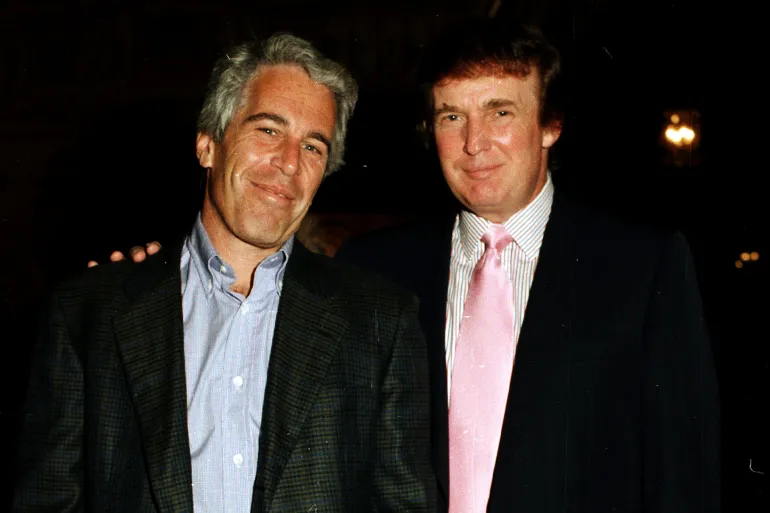أتسائل ما هو المحرك السيكولوجي الذي دفع “نخبة العالم الغربي” — من ساسة وأكاديميين وأقطاب مال — للانخراط في هذا المستنقع الجماعي؟
لماذا وقع الاختيار على “جزيرة خاصة” لتكون مسرحًا لهذه الأفعال، بدلاً من ممارستها في قصورهم الشخصية؟
ولما كان بعضهم متورطون بهذه الجرائم حتى قبل أن يصبحوا رؤساء لأمريكا أو أغنى رجال الأعمال في العالم؟
هل نحن أمام عملية استخباراتية ممنهجة صممتها جهة غامضة بهدف “صناعة الابتزاز” لاستخدامها كأوراق ضغط عند الحاجة؟
ومن هي هذه الجهة؟
وما هو التفسير المنطقي لظهور القضية وانفجارها في هذا التوقيت تحديدًا، وليس قبل أو بعد، مع أن الجرائم ارتكبت قبل ذلك بعقود؟
هل هذه القضية أول قضية من نوعها على مر التاريخ أم هناك قضايا مشابهة إلى حد كبير؟
فضيحة الدولة العميقة الأمريكية، هل ورائها دولة أعمق منها؟
في بريطانيا عام 2011، ظهرت جريمة اعتداء واغتصاب فتيات مراهقات وقاصرات، وكان بطلها جيمي سافيل، مقدم البرامج الشهير في (بي بي سي) والمقرب من العائلة الملكية البريطانية.
هذه الفضيحة ورّطت نخبة من السياسيين ورجال الأعمال البريطانيين، والغريب أن بعض تلك الأفعال كانت تُرتكب داخل استوديوهات بي بي سي نفسها.
وبعد ظهور الفضيحة، انتهت القضية باعتذار المؤسسة ودفع تعويضات مالية، ليُغلق الملف نهائيًا وتختفي القضية من التداول الإعلامي.
وفي عام 2017، ظهر ملف منظمة سرية تسمى “نيكسفم” برئاسة رجل يدعى كيث زنيري بمنطقة معزولة في نيويورك.
هذه المنظمة كانت تدعي أنها تهتم بتطوير الذات وبناء القادة، لكنها كانت متورطة في الاتجار الجنسي، والاعتداءات الجنسية، والعمل القسري، واستغلال القاصرات.
في هذه الجزيرة كان هناك تقديم قرابين للشياطين، ودبح البشر، وعبادة الشيطان.
حكمت المحكمة على رئيس المنظمة بمئة وعشرين عامًا في السجن، والمتورطون الآخرون كانوا أكثر من 100 شخص لم يحاكم منهم أحد، والسبب غير معروف.
عندما يمتلك الإنسان نفوذًا واسعًا، ويصبح قادرًا على الحصول على كل ما تشتهيه نفسه من ملذات وشهوات، قد يفقد القدرة على الاستمتاع بالجمال الطبيعي للحياة.
ربما لو نظر إلى أجمل بنت في العالم، تبدو وكأنها لا شيء مقارنة بعلاقاته السابقة مع آلاف البنات.
هذا الواقع يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالملل والبحث عن تجارب غير مسبوقة لكسر الروتين وإشباع الرغبات، فتظهر سلوكيات شاذة ومرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا.
مثل الاعتداء الجنسي على بنات قاصرات أو الانخراط في أنشطة إجرامية خطيرة، كما وثقت الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في ملف إبستين.
اختيار جزيرة منعزلة خارج حدود الولايات المتحدة لم يكن محض صدفة، بل كان قرارًا لوجستيًا لتوفير بيئة محصنة بعيدًا عن أعين الرقابة والقانون.
بالنسبة لسياسيين ورجال أعمال اعتادوا العيش تحت الأضواء الكاشفة، كانت هذه الجزيرة تمثل “الملاذ الآمن” والفرصة النادرة لممارسة أشد الأفعال تطرفًا في عزلة تامة وصمت مطبق.
حيث يتم التحكم في هوية الداخل والخارج بدقة متناهية، مما يمنحهم شعورًا بالحصانة المطلقة والتحرر من أي تبعات قانونية أو أخلاقية.
مما لا يدع مجالًا للشك، أن جيفري إبستين كان عميلاً للموساد، ومسيرته المريبة تشير إلى ارتباط وثيق بجهاز الموساد الإسرائيلي.
فمن شاب أخفق في مساره التعليمي ومنحدر من أسرة فقيرة، إلى رجل أعمال يمتلك نفوذًا طاغيًا وصاحب شركات وبنوك، تبرز علامات استفهام حول الجهة التي صنعته.
الفرضية الأرجح هنا أن إبستين كان أداة استخباراتية، ومهمته الأساسية هي هندسة “فخ التوثيق” لاستخدام الجرائم الأخلاقية كأوراق ضغط استراتيجية في المستقبل.
هذا المخطط استهدف “صيدًا ثمينًا” شمل شخصيات مثل إيلون ماسك، وأوباما، وترامب، حتى قبل وصولهم لقمة النفوذ العالمي.
أما توقيت انفجار هذه الفضائح حاليًا، فقد لا يكون بمعزل عن ضغوط تمارسها دوائر إسرائيلية لدفع الإدارة الأمريكية نحو مواجهة عسكرية شاملة مع إيران.
وهو المسار الذي أبدى ترامب وغيره تحفظًا تجاهه، مما جعل من هذه الملفات القديمة سلاحًا سياسيًا جاهزًا للاستخدام في اللحظة الحرجة.
أنا لا أعتقد كما يعتقد البعض أن هناك قوة غامضة تسيطر على النخب السياسية والاقتصادية في العالم سيطرة كاملة.
ربما بعض الجهات لها أوراق ضغط أو نفوذ في دوائر معينة، ولكن نظرية “التحكم عن بُعد” في مصير الكوكب تفتقر إلى الواقعية.
والدليل القاطع على ذلك هو الإخفاقات الغربية المتكررة وفشلها مثل العراق، الصومال، الفلبين، وأفغانستان.
أين كانوا وقت صعود الصين وروسيا اقتصاديًا وعسكريًا إلى أن صاروا قوى عظمى منافسة لأمريكا؟
الحقيقة هي أن السيطرة في هذا العالم تخضع لموازين القوى والمصالح المتضاربة بين الدول، وهناك سيطرة جزئية لبعض القرارات في بعض الدول من دول أخرى ومن بعض العائلات، وما عداه أعتقد أنها نظرية مؤامرة لا أكثر.
إنهيار أمريكا بدأ، وتشكل النظام العالمي الجديد بداياته تبدو لنا اليوم.
وفي ظل هذا التحول التاريخي، من الضروري أن نكون كمسلمين ضمن الأقطاب المشاركة في صناعة القانون الدولي الجديد والجلوس على طاولة القمة حيث تُرسم ملامح المستقبل.
تركيا، باكستان، إيران، السعودية، مصر، وباقي الدول المسلمة أمامها فرصة تاريخية نادرة.
فالتاريخ يعلمنا أن المنتصر هو من يخط القوانين، ومن لا يملك مقعدًا على “طاولة المنتصر” سيكون حتمًا الضحية للنظام العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية بالضبط.