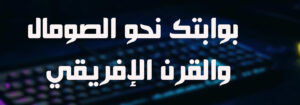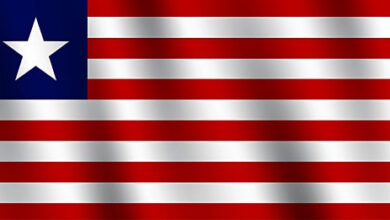ليست المأساة الكبرى التي يرزح تحتها المسلمون اليوم محصورة في حجم القتل والدمار الواقع عليهم، بل تكمن الكارثة الأشد في أن هذا القتل بات ممكنًا، متكررًا، وقليل الكلفة على من يمارسه. فالتاريخ لم يُفاجأ يومًا بوجود الظلم، إذ لم يخلُ عصر من طغيان واستبداد، لكنه يقف مذهولًا أمام أمة تآكل وزنها الحضاري والسياسي إلى حدّ أصبح فيه دمها مستباحًا، وأضحى موت أبنائها حدثًا عابرًا لا يستدعي من العالم أكثر من بيانات فاترة ، ولغة خاوية من أي التزام حقيقي.
وقد استوقفني ذات يوم نداء المرأة: «وا معتصماه»، بوصفه تعبيرًا عن قوة حضارية كانت تحمي المظلوم وتفرض هيبتها، غير أن الواقع الراهن جاء كصفعة قاسية، كأنها فأس هوت على أعناقنا، لتغدو غزة اليوم مرآة فاضحة لما آل إليه حال الأمة؛ أمة تواجه القتل اليومي، والانكسار السياسي، والعجز عن صون قيمها وحماية دماء أبنائها. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من تسليط الضوء على ما يجري في غزة، لا بوصفه مأساة إنسانية فحسب، بل باعتباره كاشفًا لحالة الوهن التي جعلت الدم المسلم بلا وزن، وأسهمت في اختلال ميزان العدالة الدولية التي لم تعد تنحاز إلا للأقوياء، تاركة الأمة الإسلامية في مواجهة صمت عالمي موحش وغياب حضاري وسياسي خانق.
إن ما يحدث في غزة لا يمكن فهمه كحادثة منفصلة أو فصل عابر من صراع ممتد، بل هو نتيجة طبيعية لمسار حضاري وسياسي طويل انتهى بالمسلمين إلى حالة ضعف شامل؛ ضعف في الإرادة، وغياب المشروع، وعجز عن تحويل القيم إلى قوة فاعلة في الواقع. فالأمم، من منظور حضاري، لا تُهزم أولًا في ميادين القتال، وإنما تُهزم حين تفقد موقعها الأخلاقي وقدرتها على فرض معاييرها، وحين تنحدر من فاعل مؤثر في التاريخ إلى مجرد موضوع للاختبار والتجربة.
في التصور الإسلامي، للحياة الإنسانية حرمة مطلقة، والدماء ليست أرقامًا تُحصى، والعدالة لا تُجزأ ولا تُنتقى. غير أن هذه القيم، حين لا تسندها قوة سياسية وحضارية قادرة على حمايتها، تتحول إلى خطاب أخلاقي معزول، محترم في النصوص، مداس في الواقع. وهنا تتجلى المأساة الحقيقية: أمة تملك رصيدًا أخلاقيًا هائلًا، لكنها عاجزة عن فرضه معيارًا مُلزِمًا، لا لأن العالم يرفض القيم، بل لأنه لا يكترث بالضعفاء.
وتتجسد هذه الحقيقة في غزة بأبشع صورها. فجثة واحدة لإسرائيلي كفيلة بأن تتحول إلى أزمة دولية كبرى؛ تُجمّد المفاوضات، وتُستدعى العواصم، وتُمارس الضغوط، وتُستنهض مفردات “الإنسانية” و”الكرامة” و”حقوق العائلات”. يصبح الجسد الميت قضية سيادية لا يمكن تجاوزها، لأنه مسنود بكيان قوي، وتحالفات متينة، وسردية مهيمنة تفرض نفسها على العالم، فيما حُوِّل القانون الدولي إلى أداة انتقائية، يُستدعى لخدمتهم ويُغيب عند اعتداء الآخرين.
في المقابل، يُقتل الفلسطينيون جماعيًا، وتُدفن أجسادهم تحت الركام، أو تُمحى هوياتهم، أو يُتركون بلا وداع. لا تتحول هذه الجرائم إلى أزمات سياسية، ولا تُربك النظام الدولي، ولا تهدد توازناته. تمر صور الأطفال القتلى سريعًا في هامش الأخبار، كأنها مشاهد مألوفة لا تستحق التوقف. هذا التفاوت الصارخ ليس خللًا عابرًا، بل نتيجة مباشرة لاختلال ميزان القوة، ولضعف إسلامي أخرج الدم المسلم من دائرة “المحرّم” سياسيًا.
ولا يقتصر هذا الضعف على فلسطين وحدها، بل هو سمة عامة في الجسد الإسلامي. أمة يتجاوز عددها المليار، تمتلك ثروات هائلة، وموقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية، وإرثًا حضاريًا عميقًا، لكنها عاجزة عن تحويل هذا الثقل إلى نفوذ سياسي مؤثر. فالانقسام، والتبعية، وغياب المشروع الجامع، جعل القضايا الإسلامية تُدار من خارج إرادتها، ويُتخذ القرار بشأنها دون مشاركة أصحابها.
حتى الهدنة، التي يُفترض أن تكون التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، تحولت في الحالة الفلسطينية إلى أداة لقياس مدى ضعف الضحية. تُنتهك الهدن، ويُستأنف القتل، دون أن يترتب على ذلك ثمن حقيقي، لأن الطرف الذي يُقتل لا يمتلك أوراق ضغط، ولا غطاءً دوليًا، ولا قدرة على فرض كلفة سياسية أو أخلاقية على من ينتهكها. وهنا يتجلى المعنى العميق للضعف: أن تُقتل دون أن تُحرج قاتلك.
أما قضية الأسرى الفلسطينيين، فهي شاهد دامغ على انهيار ميزان العدالة. آلاف الأسرى، كثير منهم أطفال ومرضى، وأشخاص قضوا سنوات طويلة دون تهم واضحة. هذه الوقائع موثقة، لكنها لا ترتقي إلى مستوى الأزمات الدولية، لأن من يمثل هؤلاء الأسرى لا يملك النفوذ اللازم لفرض قضيتهم على الأجندة العالمية.
في المقابل، يُقدَّم الأسير الإسرائيلي باعتباره رمزًا للإنسانية المنتهكة، وتُسخّر كل الأدوات السياسية والإعلامية من أجل إطلاق سراحه. المشكلة هنا ليست في التعاطف مع الأسير، بل في غياب الحد الأدنى من التوازن الأخلاقي. وهذا الخلل ليس صدفة، بل نتيجة واقع يدرك فيه العالم أن تجاهل معاناة المسلمين لا يترتب عليه ثمن يُذكر.
ومن منظور ديني حضاري، فإن ما يعيشه المسلمون اليوم هو ثمرة فقدان شرط “الشهادة على الناس”، لا بمعناه الوعظي المجرد، بل بمعناه الحضاري؛ أي أن تكون الأمة نموذجًا يُحتج به، وقوة يُحسب لها حساب، وعدالة لا يمكن تجاوزها. وحين تفقد الأمة هذا الموقع، تصبح قيمها بلا حراس، ودماؤها بلا وزن.
غزة، بهذا المعنى، ليست مجرد مأساة إنسانية، بل جرس إنذار حضاري. إنذار بأن الضعف إذا طال، تحوّل إلى حالة طبيعية، وأن الظلم إذا لم يُواجه بقوة منظمة، يصبح سياسة مقبولة. فالعالم لا يتحرك بدافع الشفقة وحدها، بل تحكمه المصالح، والخوف، والاحترام. وحين يغيب الاحترام، يغيب كل شيء.
إن الإقرار بأن ما يجري هو نتيجة ضعف المسلمين اليوم ليس جلدًا للذات، بل خطوة ضرورية لفهم الواقع. فالأمم التي ترفض الاعتراف بعللها محكوم عليها بتكرارها. وما لم يتحول هذا الوعي إلى مشروع سياسي وحضاري يعيد للإنسان المسلم قيمته، ويجعل دمه خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، فإن المآسي ستتكرر، وستظل غزة اسمًا يتبدل، بينما الجوهر واحد.
وفي الختام، فإن السؤال الذي تطرحه غزة لا يُوجَّه إلى العالم وحده، بل يُلقى أولًا في وجه المسلمين: هل سيبقون أمة يُرثى لحالها، أم أمة تُفرض كرامتها؟ فالتاريخ يعلّمنا أن الدم، في منطق السياسة، لا يُصان لأنه مظلوم، بل لأنه محمي بقوة تعرف كيف تجعل الظلم مكلفًا. وما يجري في غزة ليس نهاية المطاف، بل حلقة في مشروع توسعي لا يتوقف عند حدودها، مشروع يسعى إلى الهيمنة على المنطقة، واستباحة الأرض، وطمس الهوية، والاعتداء على مقدسات المسلمين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى وسائر المقدسات. إن الصمت عن غزة ليس حيادًا، بل تفريطًا، لأن من يعجز عن حماية دمه اليوم، سيعجز غدًا عن حماية أرضه ومقدساته ووجوده ذاته. ومن هنا، فإن الدفاع عن غزة ليس قضية إنسانية عابرة، بل معركة وعي وكرامة، ومعيار بقاء لأمة إن أرادت أن تكون، لا أن تُستباح.