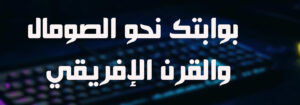كانت مقديشو في الماضي عاصمةً للمسلمين في منطقة القرن الإفريقي، يمتدّ نفوذها الديني والاقتصادي والسياسي حتى سواحل موزمبيق. غير أنّ تأثيرها بدأ يضعف تدريجيًّا بعد أن استولى العُمانيون على باتا وزنجبار، فتقلّص نفوذها السياسي شيئًا فشيئًا.
وازداد هذا الضعف وضوحًا حين تقاسمت القوى الاستعمارية — بريطانيا وإيطاليا وفرنسا — الأراضي الصومالية، فغدت مقديشو عاصمةً للجزء الجنوبي من البلاد، قبل أن تتوحّد مناطق الشمال والجنوب لاحقًا تحت راية الدولة الصومالية الحديثة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت مقديشو العاصمة الرسمية للصومال المستقلّ، واستعادت شيئًا من مكانتها التاريخية في المشهد السياسي والجغرافي، لتبقى القلب النابض للدولة الجديدة بعد زوال الاستعمار وتقسيماته.
غير أنّ العقود الأخيرة، ولا سيّما بعد انهيار الحكومة المركزية، شهدت بروز فئاتٍ متباينة — من سياسيين وزعماء قبائل ومثقفين مزعومين — تعارض فكرة أن تبقى مقديشو العاصمة الدائمة للدولة الصومالية. كما ظهرت جماعاتٌ أخرى تُثير دعاوى دستورية تهدف إلى تقليص مكانتها السياسية، والجحود لدورها الرائد والمحرّك في إعادة بناء نظام الدولة في الصومال، عبر نقاشاتٍ سطحيةٍ تُثار في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، تفتقر إلى العمق والرؤية الوطنية.
واليوم، ومع ما كان لمقديشو عبر القرون الوسطى من تاريخٍ مجيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين في منطقة القرن الإفريقي والعالم الإسلامي، فإنّها لا تزال الرمز الباقي لوحدة الصوماليين واستقلالهم، والعاصمة التي تُجبى فيها وحدها ضرائب الحكومة المركزية، وتضمّ ما يقارب نصف سكان البلاد المقيمين داخلها. كما تُعدّ أكثر المدن تسامحًا واحتواءً لمختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية والمكوّنات الاجتماعية، رغم ما تعانيه من تخريبٍ وعدوانٍ متكرّرٍ على أمنها واستقرارها، أودى بحياة كثيرٍ من أبنائها وأثقل كاهل اقتصادها.
ومع ذلك، تبقى أكبر معضلةٍ تواجه مقديشو — مدينةً وسكّانًا — هي حرمانها من حقوقها السياسية في ظلّ النظام الفيدرالي القائم، الأمر الذي جعلها ضحيةً دائمةً ومُتَّهَمةً على الدوام، بدل أن تُكرَّم لما قدّمته من تضحياتٍ وصبرٍ طويل. فكثيرٌ من السياسيين، حتى أولئك الجالسين في البرلمان أو المحسوبين على المعارضة، يُظهرون امتعاضًا من فكرة إنصافها، ويعملون على إبقائها في حالة تهميشٍ مقصودٍ وممنهج.
ويأتي في مقدّمة هؤلاء الرئيس حسن شيخ محمود، الذي مرّ بفترتين رئاسيتين أطلق خلالهما وعودًا كثيرةً لسكان مقديشو لم يُنفَّذ منها شيء، بل استغلّ معاناتهم لأغراضٍ سياسيةٍ بحتة. فحين كان معارضًا للرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو، جعل من مقديشو شعارًا لنضاله وطالب بحقوقها، لكنه ما إن وصل إلى الحكم حتى تحوّل من مدافعٍ عنها إلى ناكرٍ لجميل أهلها الذين وقفوا إلى جانبه في تلك الحقبة، ظنًّا منهم أنّه سيكون المدافع عن حقوقهم، ولكن دون جدوى.
وفضلًا عن ذلك كلّه، يسعى حزب العدالة والتضامن (أو العدالة والوحدة) الذي يترأسه الرئيس الحالي إلى تمرير مشروع الانتخابات المحلية في مقديشو دون أن يضمن لسكانها حقوقًا سياسيةً حقيقية أو ضماناتٍ قانونية تكفل لهم التمثيل العادل. وإن استمرّ هذا التوجّه، فسيفاقم خيبة الأمل لدى المجتمع المقدشي، ويُعمّق شعورهم بالتهميش السياسي مقارنةً ببقية الولايات الفيدرالية.
وإن مضى هذا النهج دون تصحيح، فسيؤدي إلى اتساع الفجوة بين مقديشو والنظام الفيدرالي، ويقوّض ما تبقّى من الأمل في تحقيق العدالة السياسية والمساواة الوطنية بين أبناء الصومال. لذا، لا بدّ من إعادة النظر في مشروع الفيدرالية القائم على المحاصصة، وبنائه على أسسٍ عادلةٍ توازن بين الحقوق والواجبات، بحيث يُقيم كلّ إقليمٍ على قدر عطائه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
إنّ مستقبل الصومال مرهونٌ بقدرته على بناء نظامٍ سياسيٍّ عادلٍ يُنصف العاصمة وأهلها، ويمنحها المكانة التي تستحقّها؛ لا باعتبارها مجرّد مدينة، بل قلبًا نابضًا لوحدة البلاد ورمزًا لسيادتها واستقلالها. فأيّ إهمالٍ لمقديشو هو في حقيقته إهمالٌ لروح الدولة الصومالية وتقويضٌ لآمالها في الوحدة والبقاء.
ولا يمكن لأيّ مشروعٍ سياسيٍّ أن يكتب له النجاح ما لم يُبنَ على أسس العدالة والمواطنة والمصلحة الوطنية العليا.
ولعلّ مقديشو، التي صبرت على الجراح وتمسّكت بوحدتها، لا تنتظر من أبنائها سوى الوفاء؛ فهي لا تطلب امتيازًا ولا تفوّقًا، بل عدلًا يُعيد إليها اعتبارها، وإنصافًا يصون مكانتها وحقوقَ أهلها المحرومين، لتبقى — كما كانت عبر التاريخ — قلبَ الصومال النابض، وميزانَ عدالته، وبوّابةَ مستقبله المشرق.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي