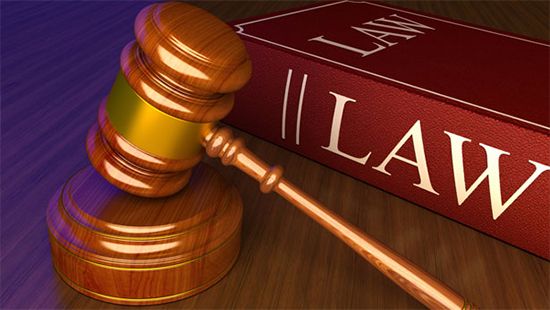انتشار الفكر المتطرف في الصومال ليس ظاهرة حديثة، بل هو نتاج تراكمات تاريخية واجتماعية ودينية امتدت عبر القرون. كما ساهم التنافس بين المكونات القبلية والفكرية الكبرى في تأجيج الصراعات والخصومات، مما أضعف البنية الاجتماعية والدينية للمجتمع ومهّد الطريق لظهور أشكال أشد حدة من التطرف في العصر الحدي.
تجسّد هذا التوتر في النزاعات القبلية المستمرة، حيث كانت القبائل أحيانًا تلجأ إلى الصراع مع أقربها نسبيًا إذا لم تجد خصومًا آخرين، وهو نمط يتكرر أيضًا بين التيارات الصوفية، التي كانت تتصارع فيما بينها حتى عند غياب تيارات منافسة أخرى. ويظهر هذا بوضوح في الصراعات الداخلية بين الطرق الصوفية قبل ظهور الصحوة الإسلامية في الساحة الصومالية.
ومع ظهور حركة الأحمدية الصالحية في القرن التاسع عشر، كحركة إصلاحية صارمة تجاه بعض الممارسات الصوفية، مثل زيارة القبور وتقديس كرامات الأولياء، والتي اعتبرتها مخالفة للسنة النبوية، تصاعدت النقاشات إلى مواجهات دامية في مناطق مثل أومبلي وبراوي وبارطيرى.
انهارت الإمارة الإسلامية في بارطيري بالكامل إثر هذه الصراعات، التي قادتها تحالفات قبلية–دينية موالية للطريقة القادرية، بدعم مالي وعسكري من سلطنة زنجبار حيث جاء تدخل زنجبار لدوافع سياسية وتجارية، إذ رأت في توسع الإمارة الإسلامية الأحمدية الصالحية تهديدًا لاستقرار القبائل المحيطة وطرق التجارة البحرية والبرية المهمة لموانئها.
وقد رُوّج لهذه الحملة بفتوى الشيخ عبد الله القُطبي في كتابه رسائل الخمسة كما وثّق الشيخ آدم سعيد في كتابه الإمارة الإسلامية في بارطيرى ما رافق الحملة من انتهاكات، شملت حرق مكتبات، وقتل علماء، وتشريد الأهالي، ما يوضح أن النزاع لم يكن مجرد صراع ديني، بل امتزجت فيه الاعتبارات السياسية والتجارية مع الدين، ممهّدًا لظهور بيئة خصبة للتطرف الفكري والعنف باسم الدين لاحقًا.
مارس أتباع الأحمدية الصالحية من جانبهم ضغوطًا عنيفة على أتباع القادرية، خصوصًا في عهد السيد محمد عبد الله حسن، وشملت هدم الزوايا، منع حلقات الذكر، والاعتداء على المخالفين كما تعرّض مركز بيولاي، بقيادة الشيخ أويس القادري، لهجمات متكررة من طرف الدراويش الصالحية، ما أسفر عن مقتل الشيخ أويس وعدد من مريديه وحرق المركز.
توضح هذه الانتهاكات المتبادلة أن النزاع لم يكن محصورًا في مسائل فقهية أو روحية فقط، بل تحوّل إلى نزاع دموي حمل ملامح مبكرة للفكر المتطرف، مثل التكفير والإقصاء واستخدام العنف باسم الدين. وقد أسست هذه الممارسات ثقافة الصراع الديني التي سيعاد إنتاجها لاحقًا بصيغ أكثر حدة مع الحركات الجهادية المعاصرة، مثل حركة الشباب المجاهدين.
وفي مطلع التسعينيات، شهدت الصومال موجة جديدة من الصراع الفكري والدعوي، تمحورت حول العلاقة بين الطرق الصوفية التقليدية والحركات الإسلامية السلفية، حيث تبنّت الأخيرة خطابًا إصلاحيًا نقديًا ركّز على ممارسات الصوفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي، تنظيم الموالد، زيارة الأضرحة، وحلقات الذكر، معتبرة إياها بدعًا، بينما دافعت الصوفية عن هذه الممارسات باعتبارها جزءًا أصيلًا من الموروث الديني والاجتماعي.
لم يقتصر الخلاف على ثنائية الصوفية/السلفية، بل شهدت الحركات الإسلامية الحديثة انقسامات داخلية عميقة. ركّزت التيارات الإخوانية على العمل المؤسسي والتربوي طويل المدى وقضية الحاكمية، بينما تبنّت التيارات السلفية نهجًا أكثر تشددًا في مسائل العقيدة، الولاء والبراء، وإنكار البدع.
أسفر هذا التباين المنهجي عن تنافس حاد تحوّل أحيانًا إلى صراع علني على النفوذ داخل المساجد والجمعيات الخيرية ومؤسسات التعليم الديني، مما انعكس على الرأي العام الصومالي بحالة من الحيرة تجاه تعدد المرجعيات الدينية.
وقد عبّرت الثقافة الشعبية الصومالية عن هذه الحالة من الارتباك في مثل متداول يقول: «حيرني العلماء». وتُروى قصة رجل أراد أداء حاجته تجاه القبلة، فنهاه عالم، فاستدار ليستدبر القبلة، فنهاه آخر، حتى جلس محتارًا وهو يردد: «حيرني العلماء»، ما يعكس حالة الحيرة النفسية التي واجهها المجتمع الصومالي آنذاك.
ومن رحم هذه الانقسامات الفكرية والتنظيمية، ظهرت جماعات أكثر تطرفًا، أبرزها جماعة “التكفير والهجرة” وجماعات محلية مثل “تكفير الجوي”، التي اتسمت في البداية بموقف متردد بين تكفير المجتمع والانفصال عنه من خلال ما يُعرف بـ”الهجرة”، أي الانسحاب إلى عزلة سرّية وباطنية ولكن بعد عقدين من الزمن، نهجت هذه الجماعات منهجًا مشابهًا لجماعة التكفير والهجرة المصرية، مستلهمةً مفاهيم مثل الحاكمية والتكفير بالمعصية والمفاصلة الشعورية، ما أدى إلى تبني مواقف تكفيرية شملت قطاعات واسعة من المجتمع الصومالي، بما في ذلك الطرق الصوفية، التيارات السلفية والإخوانية، فضلاً عن عامة الناس.
بفعل القطيعة الفكرية والاجتماعية، وجدت هذه الجماعات نفسها معزولة عن البنية القبلية والدينية التقليدية، مما حدّ من انتشارها الجماهيري، لكنها تركت أثرًا عميقًا على البنية الفكرية للحركات الإسلامية وأسهمت في تهيئة المناخ الأيديولوجي والنفسي لظهور أشكال أشد تطرفًا خلال العقدين التاليين.
كما ساهمت عوامل أخرى في تغذية الفكر المتطرف، من أبرزها: الارتباط بالشبكات الفكرية والتنظيمية العابرة للحدود، تأثير الإعلام الحديث، افتعال خلافات إدارية داخلية في التيارات الدعوية، هشاشة مؤسسات الدولة، ضعف منظومة التعليم الرسمي والرقابة الأمنية، تفاقم الفقر والبطالة، والتدخلات الخارجية.
إن دراسة جذور الفكر المتطرف الخارجي في الصومال تتطلب فحص الترابط العميق بين العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية. فالانقسامات القبلية المستمرة والصراعات بين التيارات الدينية لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل ساهمت في تأسيس بيئة مؤاتية لنمو التطرف الفكري والعنف المسلح القائم حاليا المتمثلة في الحركات المسلحة.
لقد لعبت الهياكل القبلية المترابطة، القائمة على الولاءات العشائرية، دورًا أساسيًا في تعزيز الانقسامات، بينما استغلت بعض التيارات الفكرية هذه التوترات المسلحة لترسيخ مواقف متشددة، بما في ذلك تكفير المخالفين والإقصاء العنيف. إضافة إلى ذلك، أسهمت العوامل الاقتصادية، مثل التحكم في الموارد الطبيعية وطرق التجارة، في تعقيد الصراع وارتباطه بالمصالح المادية.
توضح هذه العوامل مجتمعة أن التطرف في الصومال ليس ظاهرة مفاجئة، بل هو نتيجة تراكمية لتفاعل متشابك بين الدين والمجتمع والسياسة والاقتصاد، مما يجعل من الضروري اعتماد منهج تحليلي متعدد الأبعاد لدراسة هذه الظاهرة وفهم آليات تطورها.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي