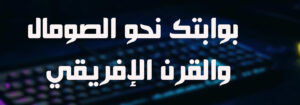في كل موسم انتخابي بالصومال، تتكرر الصورة نفسها بلا تغيّر؛ مجموعة من المتنافسين يظهرون على الساحة وهم يتزيّنون بشعارات الوطنية والإصلاح، فيما تعمل وسائل الإعلام على تلميع بعضهم بحرفية مدروسة. لكن الواقع يكشف، عند التدقيق، عن امتدادات خارجية واضحة — غربية أو عربية أو إقليمية — وعن ارتباطات بمنظمات ذات نشاط سياسي أو ديني مشبوه تتخفّى خلف الأقنعة المدنية والسياسية، وربما تتقاطع مصالحها مع جماعات عابرة للحدود.
مع مرور الوقت، ترسّخ لدى قطاعات واسعة من الصوماليين اعتقاد مفاده أنّ المرشّح المدعوم خارجيًا هو الأكثر حظًا بالفوز، وأن الطريق إلى السلطة لا يمرّ عبر الكفاءة أو البرنامج السياسي، بقدر ما يعتمد على حجم الدعم المالي والسياسي القادم من خارج البلاد.
ولم يَعُد هذا الاعتقاد مقتصرًا على سباق الرئاسة، بل امتدّ إلى تشكيل البرلمان أو الوزاراء وحتى المدراء في ظوائر الدولة؛ إذ صار تقييم الشخصية مرتبطًا في كثير من الأحيان بميزانية حملته والجهة التي تموّله، لا بقدرته وعلمه بالشرون الساسية أو لشعبيته أو رؤيته للإصلاح أو مشروعه لإنهاء دوامة الفشل السياسي التي لازم البلاد منذ الاستقلال.
والأعجب أن الرئيس، وكذلك الوزراء والمدراء، يصلون إلى مواقعهم بنفس الآلية؛ إذ تطغى الولاءات الخارجية والمحاصصة القبلية على معايير الكفاءة والخبرة. وليس هذا مبالغة، فكم من مسؤول تسلّم منصبًا حساسًا رغم أن سجله يشير إلى انتمائه لجهات أجنبية، أو ارتباطه بجمعيات ذات نشاط ديني مشبوه، أو ضعف كفاءته الواضح، أو سلوكه الذي يتناقض مع القيم الإسلامية للشعب. وهذا الواقع ينطبق من أعلى الهرم إلى أدناه، مما يبرز الخطر المحدق بمستقبل البلاد.
ولا يمكن فهم هذا العبث إلا في سياق نظام المحاصصة القبلية الذي فُرض تحت غطاء الفيدرالية؛ إذ جرى تقييد المناصب العليا بقبائل محددة، وحُرمت قبائل كثيرة من أصحاب الكفاءات والخبرة القادرة على البناء والإصلاح. وبهذا النظام صعد أشخاص لا يمتلكون أدوات القيادة، بينما أُبعد الأكفّاء وتراجع صوت العقل لصالح النفوذ والمساومات.
وتبرز في هذا السياق حادثة جرت فعلًا في إحدى الوزارات؛ إذ تولّى حقيبتها شخص كانت تحوم حوله اتهامات تمسّ أصله الديني. وما إن استقر في منصبه حتى أحاط نفسه بأشخاص لا يرون في الإسلام منهجًا ولا مرجعية، وكان بعضهم متورطين في أنشطة تنصيرية تستهدف الهوية الصومالية في القرن الأفريقي، حتى أصبحوا مستشارين ومديرين وسكرتاريين في الوزارة.
وعندما أُعفي الوزير وجاء خلفه وزير جديد، وجد وزارة مشبعة بهذه الوجوه المشبوهة وقد انحرفت عن مسارها الطبيعي. فأطلق مشروعًا لإصلاحها، لكنه اصطدم بضغوط شديدة من بعض السفارات الأجنبية المستفيدة من استمرار تلك الشبكات. ومع ذلك مضى بعزم ثابت حتى نجح في كشف تلك العناصر وإبعادها عن مواقع التأثير وإعادة ترتيب الوزارة على أسس سليمة.
وليس هذا المثال بعيدًا عن اختيار النواب السبعة لبرلمان “شرف أفريقيا”، إذ ضمّت القائمة أشخاصًا جاهروا بإنكار بعض الثوابت الإسلامية، وطعنوا صراحة في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. ومع ذلك انتهى بهم الأمر إلى تمثيل شعب مسلم، إمّا بفعل نظام المحاصصة القبلية، أو تحت تأثير الضغوط الخارجية، أو نتيجة الرشاوى والمال السياسي والنفوذ الإعلامي.
والمشهد الأكثر إيلامًا أنّ المرشّح — سواء للرئاسة أو الوزارة أو البرلمان — الذي صعد بدعم خارجي ظاهر، يتوقع منه الشعب بعد فوزه أن يتحول فجأة إلى «وطني مخلص» يعمل لصالح الصومال وحده! أمنية جميلة، لكنها بعيدة عن الواقع السياسي؛ فالولاء لغير الوطن لا يمكن أن يتقاطع مع خدمة المصلحة الوطنية كما قال الله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾.
وكما أن الأرض الخبيثة لا تُنبت زرعًا طيبًا، كذلك لا يُرتجى خير من نظام سياسي جائر، أو من وكلاء ينفذون أجندات خارجية، أو من نظام انتخابي اختلت معاييره منذ جذوره. وما لم تُعالج هذه الاختلالات بإصلاح جذري، يستند إلى العدالة ومبادئ الشريعة، ويضع الكفاءة والولاء للوطن فوق المصالح الشخصية والقبلبة والخارجية، ستستمر البلاد في الانحدار، وتزداد أزماتها تعقيدًا.
إن التغيير الحقيقي يتطلب شجاعة سياسية، وإرادة صادقة، وحرصًا على أن تُدار شؤون الدولة على أسس سليمة، تضمن حماية الهوية الوطنية وصون مصالح الشعب الصومالي.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي