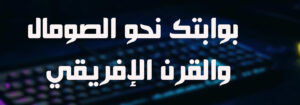إنّ السعي الحثيث لبلوغ الكمال، واحدٌ من مزايا إنسانيتنا الفريدة، ولكن حين يعضّ الجوع والفقر انتباهها فإنّها ستنظر إلى المكان الخاطئ، وغالباً فإنَّ عماءً ما سيجعل من الحاجة العصا الوحيدة التي تتكئ عليها؛ حيث ستنجح في أن تؤبّد وجودنا داخل حقل الضرورة، ثم ستصبح الحياة مرهونة فقط
بما تسمح به وتبيحه، فكل ما ليس ضرورياً ويمكن الاستغناء عنه، يصبح كماليات فارغة، ولن يضير الحياة شيئاً لو لم تتوفر عليه؛ يبدو أننا وقعنا من جديدٍ في مصيدة التناقض، فإذا كان بإمكاننا أن نستغني، تحت ظرفٍ ما، عن ما هو كمالي، فإنّ سعينا لبلوغ الكمال ونشدانه سعياً مُضللاً بالأوهام التي أنتجها الفقر والحاجة.
ففي مجتمعاتنا التي تُنتِج أنظمتها الفقرَ والجوعَ أو الوفرة المزيّفة، تنغلق الكماليات على مضامين ضيّقة، تساعد في تشتيت الانتباه عن المعنى الحقيقي لها، فتبتعد عن أنّها ما يجب أن يكمل الوجود الإنساني ويرتقي به، إلى مجرّد صياغات عارضة،
تنحصر في جملة أشياء ماديّة ذات طبيعة استهلاكية، لا يشكّل غيابها أي تهديد لحياة الفرد التي تُراوح عند حدود الحاجات الأساسية، ومن البديهيّ أن تسقط من معجم كمالياتنا الفنون بأنواعها، فهي لا وزن لها أمام الرغيف، فثقافة الحاجة تُغلق الطريق على ثقافة الحياة، والتي للأسف قد لا يدعمها في مجتمعاتنا سوى الموت.
إنّ قيمة الشيء لا تتعلق بمقدار الحاجة إليه والاستغناء عنه، بل بمقدار ما نكون عليه إذا حصلناه. فنحن إذا حصلنا الرغيف فأقصى ما نبلغه في تحصيله أن نتساوى وسائر الأحياء في إشباع الجسد وصيانة الوظائف الحيوانية، ونحن إذا حصلنا الفنون الجميلة فما نحن بأحياء وحسب ولا بأناسيّ وحسب ولا بأفراد وحسب،
بل نحن أناسيّ ممتازون نعيش في أمة ممتازة تحسّ ما حولها وتحسن التعبير عن إحساسها”. لكي نتمكّن من فهم هذا، علينا فقط أن ننظر إلى واقع حصتي الموسيقى والرسم في مدارسنا، فالهامشيّة التي تحظيان بها تشير ـــ إذا ما فهمنا العقّاد ــــ إلى فقرٍ أشدّ من الحاجة إلى الشيء، إنها تشير إلى فقرٍ مدقعٍ في الروح الإنسانية، وإلى الكيفية التي تتربى من خلالها الحواس.
فأغلبية مجتمعاتنا لا ترى في مادتي الرسم والموسيقى سوى (كماليات) المنهاج الدراسيّ، وهنا تأخذ مفردة الكماليات معنىً خاصاً، فالوعي العام لا يجد في غيابها أي تأثير على التحصيل العلمي للطفل، فمثلاً يمكننا الاستغناء عن حصة الموسيقى،
ولكن لا يمكن أن نستغني عن حصة رياضيات واحدة، أو أيّة حصة تتعلق بما يُطلَق عليه المواد الأساسية، وهذا الوعي العام هو وعينا الاجتماعي نفسه، والذي ينتج عن تربية سياسية ودينية واقتصادية، هذه التربية التي تعمّدت محاربة الفنون الإنسانية وتهميشها، كي لا تقف في مواجهة إنسان حر يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات،
والسؤال الذي شغل الكثيرين، هل الفنون الإنسانية ضروريات أم كماليات؟ تم حسمه عبر رغيف الخبز الذي يركض ويركض جميع المقهورين وراءه.
قد لا يكون هناك اكتراث في مجتمعاتنا لجملة النواتج المترتبة على غياب الحس الجمالي، طالما لا تستطيع أن تربط بينه وبين الكماليات؛ أي بين النتائج ومقدماتها؛ إذ إنّ انحدار القيم الجمالية التي ندرجها في باب الكماليات، والحرص على بقائها ثانوية وهامشيّة في مجتمعاتنا، قد تكون أحد أهم مولدات العنف الذي بإمكان الفنون أن تجففه فيما لو أوليناها اهتماماً حقيقياً، لهذا اعتقد كثيرون لو أنّ هتلر أُتيحت له فرصة أن يكون فناناً،
كنا سنرى يديه ملطختين بالألوان بدل كل الدم الذي لطخ به الإنسانية، فالكماليات التي يُراد لنا فهمها ليست سوى الوجه الآخر لعبودية نُجبر عليها، إنها تعزز منظومة الاستبداد وتجعلنا
إنّ العلاقة الجدلية التي تربط الجوهر بالمظهر، قد تذهب مباشرةً لما أرمي إليه، فالمجتمعات التي يطفو العنف والخوف على وجهها، هي المحصلّة المنطقية للقبح الذي تحرسه وتتغذى عليه، وهي بذلك المحصّلة المنطقية لمساهماتنا المتعمّدة وغير المتعمدة في إنتاج الخوف والفقر والجهل؛ أي الوجه الآخر للقبح،
لقد أصاب العقّاد مجدداً في قوله: “إنّ الضروريات توكلنا بالأدنى فالأدنى من مراتب الحياة، أما الذي يرفعنا إلى الأوج من طبقات الإنسان فهو ما نسميه النوافل والكماليات، فإذا كنا لا نبغي إلا أن نعيش كما تعيش الأحياء كافةً، فحسبنا الضروريات المزعومة، وإن كنا نبغي أن نعيش (أكمل) العيش فلا غنى إذن عن اعتبار الكماليات من ألزم الضروريات”.
ولهذا كانت الفنون بأنواعها حاضرة بقوة في ثورات العالم المعاصرة، إنها تشكّل دليلاً إضافيّاً على أهميّة الكماليات وتأثيرها العميق، تقول الأديبة والقاصة اليمنيّة هدى العطاس: “إنّ الفن من أهم العوامل الداعمة للثورات وهو غالباً ما يكون وعاءها والمعبّر عن روحها وجوهرها”، فالفنون تعكس بحسب العطاس،
ميل الفرد الأصيل للانعتاق والحرية، من حيث كونها الأداة الأكثر جذرية في التعبير الحرّ عن إنسانية الإنسان، وعن الرغبة الملحّة في حياة تتخارج عن البُنى الثقافية المتكلّسة، والمحكومة بنمطية العقائد وقسرها، فالأنهار لا تولد من ماء المستنقعات، والحياة سوف تجفّ إذا خمدت جذوة ينابيعها.
يقول ألبير كامو؛ “لسنا ننشد عالماً لا يُقتل فيه أحد، بل ننشد عالماً لا يمكن فيه تبرير القتل”، فلا يمكن استئصال الشر من العالم بصورة نهائية، ولكن من الممكن السيطرة عليه وتقليص آثاره والتخفيف من ويلاته، ونستطيع القول اليوم بأنّنا لسنا ننشد عالماً خالياً من الأوبئة أو الحرائق خلوّاً تاماً، ولكننا ننشد عالماً لا يشمت فيه الناس بمن تحلّ بهم الأوبئة أو بمن تلتهم النار بيوتهم وحقولهم وغاباتهم، ولا تغلق فيه الأبواب في وجوه المنكوبين.
تمكّنت أستراليا من احتواء الحرائق التي التهمت غاباتها وحماية السكان، ثم التفتت إلى حماية الحيوانات النازحة عن مواطنها، والتي قضى الحريق على مصادر عيشها، وبنت الصين مشفيين ضخمين على مساحة 25 ألف متر مربع، خلال 10 أيام فقط، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة ووهان؛ حيث أنفقت 200 مليار دولار حتى الآن،
وخسرت بورصتها 500 مليار، في معركتها مع هذا الفيروس، لكنّ المارد الصيني سوف ينتصر على هذه البعوضة التي قرصت ركبتيه، وجعلته موضع “شفقة” أمام العالم، وذكرت تقارير مختلفة أنّ الصينيين المحجور عليهم والمحاصرين في منازلهم، بعد أن داهمتهم الكارثة في “عيد الربيع”، اشتروا في أسبوع فقط مليار مرة بالبطاقات الائتمانية، وسددوا 100 مليار دولار، وفي حين وصف أحد المراسلين الأجانب مدينة ووهان، التي كانت الأكثر ابتلاءً، بأنّ لها مشهداً يشبه نهاية العالم لشدة ما هي مقفرة، نشرت الحكومة صوراً للمدينة