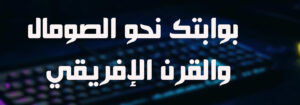تغيرت المدينة جغرافيا وأتسعت هندسيا، وتبدّلت الأحياء وتمايزت الحاراة، ومعها تغيّر السكان والجيران والمعالم!، كنت متحمسا جدا لملاقاة الأحبة ومعانقة الخلّان، فتجولت الجيران وكلي أمل ان أجد من شاركنا معهم شجار الطفولة وإبتسامتها البرئية، أوجمعتنا الساحرة المستديرة في داخل المستطيل الأخضر، وركضت نحو المرابع وأنا أردّد النكات الطفولية الساذجة التي كانت تضحكنا من الشدق إلي الشدق والأحاديث التي كنا نسامر علي طيفها.
وفي عز نشوة العودة كنت أتذكر الأسامي التي كنت أشتاقهم ويسوقني الحنين إليهم، فلم أجد إلا بضعة أشخاص متفرقين علي أحياء المدينة، لأنّ الأحباب والخلان إما رحلوا عن البسيطة، أو هاجرو عن المدينة، أو فارقوا عن الحيّ والمنازل الذين كانو نورها الوهاج في يوم من الأيام.
أتفقد البيوت بيتا بيتا، وأتردد علي الطرقات التي كانت تحوي آثارناوبصماتنا الطفولية وقت العودة من المدرسة، والأزقّة التي كنا نلعب بها فلا أجد سوى وجوه جديدة حالكة، وأطفالا شكلتهم الحروب وجعلتهم كائنات غريبة وأشباحا مخيفة، فأشتاق للماضي الفخيم والأيام التي خلت حين كان الرفقاء يتسامرون أمام بيتنا وفي فنائه المعروف بأنفيلد لكثرة ما كان الشباب يتحدثون عن الرياضة وجمالها وعن ليفربول العريق الذي كنت ومازلت أشجعه.
لم أتعرف سوى الشواطئ الوفية ومعالم المدينة المختلطة بالصدأ والرطوبة الكبيرة والبيوت الصامدة، وبعض الشوارع، والمنارات الطويلة لمسجد الحي، والشيوخ الذين يردّدون الأوراد في زاوية بعيدة من مسجد سوق يسن الذي كنت أصلي بهم في التراويح والتهجد وبعض الصلوات حين يغيب الإمام في ذاك الزمن.
كان يلازمني شعور غريب وخلجات متباينة وذبذبات طولية من الأحاسيس الجميلة والمشاعر الدافقة من معين الطفولة وتصرفاتها الصبيانية، والحداثة ونزواتها القاتلة كلما تبحّرت في الأعماق المجهولة لحارتنا، وكلما أتهيّأ للكتابة وشعرت صفاء ذهنيا أتعرض لموجة من السرحان يقطعها الزيارات التي لاتنقطع للخلّان وأصدقاء الطفولة وأبناء الجيران الذين وُلدو وترعرعو في الحيّ سنوات الغربة والضياع.
وفي متاهات الحيرة أستجمع الذكريات وأضم الأحداث والوقائع إلي بعضها حسب التواريخ، وأتمعن في أفق الزمان أقرأ وأحلل وأتذكر! ولكن تخونني الذاكرة وتهرب الوقائع عن ناظري فأطرق مليّا وأثقب جسم الخيال الواسع، وأتحملق حول الجهاز، وأحاول عصر الفكرة وبداية الكلمات فلا تسعفني الذاكرة ولاتجود القريحة كلمات رائعة ومعبرة أو تركيبا كالقلادة جميل!.
ولكن لا أستسلم وأعاود الكرة من جديد، فيتصبب العرق عن جبيني وأنا أتحسس مفاتيح الكيبورد، ليس خوفا عن الكتابة وسطور المقال ولا بحثا عن عنوان جذاب يبهر القارئ ويعقد لسانه، بل تتطائر الكلمات ويتبلد الذهن وتحجمني الحروف وينكرني الخيال وتهرب التعابير الجميلة، وتعيدني الايام إلي غابر الأزمان الملئية بالشجن والشجى، وهواجس الأفكار،وعذاب المرارات، والبسمة التي تبدد غيوم الكآبة، وقصة الدموع والدمار والدماء، وفصول التراجيديات المؤلمة في حياتنا، وأحلاما قديمة تبحث عن الدفء والوصال، وأملا جميلا يداعب الخيال.
وفي ذكر الماضي وتفاصيله وكتابة وقائعه وأحداثه السريالية والأيام المتألقات التي مضت، القلب يرتجف! والوجدان ينكسر، واللسان يتعثر، وترتعش الايادي، وتتلاشى الأفكار، وتحيط علي التعابير الجميلة والأساليب السلسة ذات الرونق والبهاء غيوما سوداء كريهة وكالحة ،هذا إذا كان المرأ يستشعر الماضي فقط، فما بالك من يقف فوق فوهة الذاكرة؟ ويستريح علي حضنها الدافئ ليكتب ويسطر ويخلد صداها عبر القرون!؟.
شجن الذكريات وشجى الأيام وعلي وقع المدينة التي كانت ملعبا لطفولتك وملهى لشبابك تجعل الكتابة معاناة من نوع آخر،! وفي أعتاب المرافئ الندية تتسابق الذكريات، وتتزاحم الوقائع في أزقات الذاكرة وطرق الوجدان فيصعب الإختيار ولا أدري من أين أبدأ؟ وماذا أكتب؟ وعن أي قريحة أستعين!؟ وأي قلم سيتحمل نزيف الزمن علي مرسال الشوق؟ وأتسآءل عن الورقة التي تستطيع حمل قوة الحنين الذي يسيل عن أعماقي وتحمل إلي الوجود آهاتي وأحلامي ومسراتي وحبوري، وعن أي مداد سيقوى كتابة الماضي الفخيم وفصول النوستالجيا العجيبة التي أحملها بين قفص الضلوع وأوتار القلوب، وعن الليالي الملاح وأيام الخوالي بكل تناقضاتها وإختلافها وسجلاتها القاتمة ولحظاتها الهنئة، وساعات النشوة التي رفرفت السعادة أجنحتها داخل القلوب الكسيرة والوجدان الجريحة والنفوس الحزينة.
وأي لغة أحتاج كي أكتب عن شاطئ الذاكرة، وعن المدينة التي لها تأثير عجيب في خيالي ، عن ريفها وتراثها الخلاب وحاراتها وأزقاتها الطويلة والمتشابكة، ومزارعها المترامية وطرقها الترابية والسريعة وشواطئها النظيفة، وعن ستات الشاى وجارنا المزعج وزاويتي المفضلة لمسجد الحي!، وعن فريقي الرياضي عندما كنا طفولا تفرحهم الكرة وتبكيهم، وعن أشبال الحي وسمراوات القوم، والنوادي الثقافية والليلية.
وعن الصبا والطفولة وكيف كانت جنّة وارفة الظلال، حيث كنّا نلعب ونمرح فإذا أتعبتنا اللعبة وأرهقنا الجري كنا نرمي أنفسنا إلي حضن الأمهات الذي يعني كل شئ في حياة الطفل، وعن المراهقة وساعاتها الجميلة والتجربة الأولي للغزل بكل أنواعه وأطيافه، وللغزل ـ ياجماعة ـ في زمن المراهقة أحاديث وأشجان، تساريح مختلفة للشعر وأناقة مبهرة وسذاجة قاتلة تجعل المراهق نجما فوق العادة تلهث الجميلات ورآئه بل كل فتاة معجبة ومتعلقة به، ودليله القوى الذي يدل علي أن الفاتنات يجرين ورآئه هو أن حوّاء تنظر إليه بإستمرار وتغنج فإذا جاوزها تضحك أو تبتسم وكلها ـ في نظرة المراهق ـ علامات الرضى والقبول!.
وعن المدرسة وطابورها الصباحي وأناشيدها العذبة والتراتيل الجماعية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، والمواد وتنوعها والفصول المدرسية، والأشجار الباسقات المغروزة في بهوها الجميل، وعن المسابقات الثقافية والأمسيات الشعرية، والأساتذة الأماجد، والمذاكرة علي ضوء القمر أو الفانوس الضعيف أو ضوء اللمبة القميئة في بيتنا المتواضع، وفي ذكر اللمبة فالتيار الكهربائي لم يصل إلي حيّنا في ذالك الزمن، لذا كان الضوء المنبعث من بيتنا مصدرا للفخر وشعورا جميلا عشته في تلك الحقبة، وكنت أتباهي ولوضمنيا أن بيتنا مختلف عن بيوت الحارة، وكأنه قصر منيف من قصور العباسين في الزوراء الجريحة.
تمر الأيام والليالي وبعض الذكريات تكون عالقة بين طيات الذكريات وحافة القلوب، كحبيبة أضفت الحياة لونا قرمزيا جميلا فرقنا الزمن وأبعدها النوى، وأماكنا تاريخية أو أثرية تعلقنا بهم، وأصدقاء الطفولة الذين عشنا معهم، وأزمانا كان الجمال يغفوا في أحضانها أجبرتنا الذكريات بعدما ودّعنا أن نذرف الدموع من أجلها، وأشخاصا كانو زينة الحياة وعقد الرمان وبهجة الكون وألق البيوت شربوا كأس المنون ألوانا وأرسلهم الموت إلي سكون القبور.
ضحكت كثيرا وأنأ أقرأ بعض الكلمات المبهمة والألغاز الصعبة والحكم الدينية والمواعيد المهمّة التي خبأتها في داخل مذكرتي الخاصة، وبعض المواعيد لأناس كان لقاؤهم في ذالك الدهر أمنية الزمان وأقصى ما كنت أتصور، كما بكيت وأنا أقرأ لسطور كتبها أخي الذي رحل إلي دار البقاء بعد إنفجار غادر إستهدف موكبه نهاية العام المنصرم.
علي صفح الجدار وفي الكتب المدرسية وبين أوراق الدفاتر التي تنؤ بالعلم والمعرفة كانت الذكريات تتناثر بين الورقة والمداد، ومن هذه الذكريات ما كتبت علي الورقة الأخيرة لكراسة الجغرافيا “لا أستأنس الغير”! كأني أسير وحدي في الفراق أو في الفلوات والصحارى العتمور، و”أحب السفر والترحال”، وتذكرت كيف كنت متحمسا للسفر، وأنه عندما يسألني الأساتذة ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ كنت أقول وبسرعة شديدة: أريد أن أكون وزيرا للخارجية، ليس حبا لمهام الوزارة الفخمة ولا لثروتها ولا لسجلها التاريخي المعبأ بالإخفاقات تلو الإخفاقات، بل إختياري كان يعتمد حبي الكبير للتنقل وشغفي الشديد للسفر والترحال، ولم أكن إختياري ومضة عابرة بل إلي يومنا هذا أمتع أيامي هي الأيام التي أجدني مسافرا فوق السيارة التي تتهادى فوق الجبال والسهول والبراري، أوعلي متن البواخر التي تلهث عباب البحر وفوق الأمواج المتلاطمة، أو فوق صهوة الطائرات التي تقطع الأميال والفلوات بدقائق وتطوى الأرض طيّا تقرب البلدان وتجعل المستحيل ممكنا.
وعندما كبرت وجدتُ نفسي محاطا بالنوى وعصى الترحال تلازمني، حتي أصبح عمري مقسما بالتساوى إلي عدة دول وعشرات المدن ومئآت القرى!، وقطعت الأميال والفراسخ، وتسللت عبر الحدود وأنا أتهرب عن عيون الشرطة ورجال الأمن أو سياج الحدود الكريه، وتدثرت لباس الخوف والمتاعب وأنا ابحث الأفضل، أو أنشد متعة السفر، أو منهمكا في العمل وسفره المغاير، أو تقودني الرحلات العلمية إلي متاهات التنقلات الإجباربة، والسير علي الأقدام وبمسافات طويلة بعدما أصبح تخصصي صنوا للرحلة وشقيقا حقيقيا للسفر والترحال.
غبت عن عروس المحيط كسمايو عقد من الزمن كان كفيلا لتغيير خريطة المدينة جغرافيا وبشريا، عشرة سنوات تجولت فيها شرق أفريقيا وشمالها، وعشت في أدغالها وأحراشها ومدنها وعلي وقع الأنغام المنعشة والرنات الحزينة والألحان الأفريقية الصاخبة، كما كنت ضيفا علي صروح العلم والمعرفة والثقافة هناك في العاصمة الوادعة علي أحضان النيل بشموخ وكبرياء، ورغم بعدي عنها إلا أن حبها لم يزل علي قلبي وشغفها كان ملهمي للإبداع والتألق وتقديم الأفضل الممكن.
هذه السنوات لم تكن هيّنة عليّ، بل كانت سنوات ثقيلة، لأني بعدت عن مهد حداثتي وملعب طفولتي وعن مدينة أطعمتني في صغري ومنحتني العلم وبهاء الحروف وسطوع المعرفة ونمير العلم المدرار في كبري، كما كانت سنوات ثقيلة علي المدينة التي خضعت لأنظمة متبايتة وأيديولوجيات متناحرة وقبائل متقاتلة وجبهات مسلحة همهم الوحيد إيثار الحكم ونهب الثروات ومصادرة الحقوق والتجارة علي عرق الجبين ولقمة البسطاء الكادحين، وانصهرت كل هذه العوامل وتخمرت كل هذه المآسي في بوتقة التخلف والدمار لتضيف سواد الحروب إلي عتمة الجهل والدم القاني الذي أصبح شعار المدينة.
وفي نهاية المطاف وأنا أتجهز للمغادرة المرتقبة ورغم الحكم المحلي الذي أعاد للمدينة بعض هيبتها كلما أستنشق عبير الهواء وعبق النسائم المحملة لدفء القلوب ومنارات الليالي القرمزية والجدران الشاهدة للصداقة تنتابني هواجس وذكريات أيقونية جميلة وتخنقني العبرات وأردد سقى الله تلك الأيام ما أجملها!.