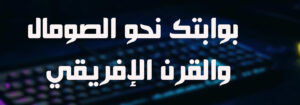كثير من الناس في هذا العالم الرحب عندما يستعرضون أحوال وأوضاع العالم الإسلامي قاطبة يتبين لهم بأنه يعيش في ذيل العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصناعيا وتكنولوجيا ، ويعشعش في بلدانهم صنوف من الظلم والقهر والاستبداد ، وأن سقف الحرية وإبداء الرأي واختيار الحاكم غير موجودة إلا في حالات نادرة ، وشعوبهم تردح وتعيش تحت فقر مدقع مع أن هذه الأوطان تحتوى في أراضيها كنوزا هائلة من الموارد والمصادر الطبيعية التي تفوق حاجة أهلها لو وجدت الإدارة الصحيحة الصالحة التي تدير هذا الثروة في كفاءة واقتدار من أجل صالح شعبها .
وعند الحديث عن سبب هذه المأساة التي يعيشها العالم الإسلامي من انسداد الأفق وسيطرة الدكتاتورية والاستبداد على مفاصل الحياة ، يُرجع كثير من المستشرقين والمتأثرين بالغرب أو المتعاطفين مع حضارتهم من ليبرالي العرب أو الذين لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا ، أو ظنوا أن بعض أخلاقيات وتصرفات الأفراد والمجتمعات المسلمة المخالفة للدين هو الإسلام الحقيقي ، اعتقدوا أن الاسلام هو السبب في هذا التخلف ، لأنه – حسب زعمهم – يشرعن حكم الفرد الواحد الذي ينجم عنه الاستبداد والتسلط ، وأن العلاقة بينه وبين هذا النوع من الحكم علاقة وطيدة وأصيلة ، ولذلك لا يعطي أتباعه حق الاختيار لمن يحكمهم ، بل يوجب عليهم السمع والطاعة للحاكم ولو كان ظالما وفاسدا ، فإذا أراد المسلمون اللحاق أو التنافس مع الأمم الأخرى يجب عليهم التحلل من تعاليم الدين في مجال السياسية والاقتصاد والحكم ، وعدم زجه في عالم الدنيا ، وحصره في مجال الاعتقاد والتصرف الشخصي وممارسته في داخل دور العبادة من غير أن يكون له تأثير في الحياة العامة .
وحجتهم الوحيدة في هذا الادعاء الكاذب هو أن التقدم الحضاري والتكنولوجي الذي حققته الدول المتقدمة إنما جاء بعد تنحية الدين عن الحياة الدنيوية وإدارتها وتم حصر تعليماته بين جدران الكنيسة ، واقناع الناس بأن الحياة لا تتقدم إلا إذا حصل انفصام كلي بين الدين والسياسة ، ويتم إعمال وتطبيق مبدأ ‘ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ‘ ، حتى لا يبقى الدين – حسب زعمهم – حجر عثرة في التفكير والابداع والتقدم .
قلت : إنما نشأ هذا الفهم المغلوط الذي يربط الاستبداد بالإسلام ويجعلهما وجهان لعملة واحدة ، بسبب الممارسات الخاطئة التي صاحبت مسيرة الممالك الإسلامية التي توارثت الحكم بعد انقضاء فترة النبوة والخلافة الراشدة على منهاج النبوة إلى يومنا هذا ، لأن نظام الحكم الذى جاء بعد ذلك لم يكن على المنهج الإسلامي الصحيح في تداول السلطة واختيار الحاكم حسب القواعد المقررة شرعا ، ولم تكن تصرفات كثير من الولاة متفقة مع شروط الولاية والحكم ، وإن وجد في أعمالهم وإداراتهم انجازات ونجاحات كثيرة وكبيرة ، ويعود هذا الإنفصال الذى حصل بين تعاليم الشرع في الحكم وبين ممارسة الحكام المخالفة لنهجه ، بأنه كلما طال زمان الوحي وبعد الناس عن التوجيه الإسلامي الصحيح تجاه المجتمع حكاما كانوا أو محكومين ، واستولت شهوة الحكم على النفوس ، تحول الحكم من عقد اجتماعي يشارك الجميع في تأسيسه وتقويمه وتصحيحه إلى مؤسسة فردية أو عائلية لا تراعي إلا مصلحتها الكامنة في استمرارها في الحكم والسيطرة ولو خالف ذلك الشرع الحنيف والعقل الصريح .
جاء الإسلام لتحرير الإنسان من عبودية البشر إلى عبودية الخالق ، وفضله على كثير من المخلوقات الأخرى ، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلناهُم عَلى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلًا ﴾ الإسراء ٧٠ ، ولا يجوز الاعتداء على حقوقه مهما كان انتمائه الديني والعرقي ، ولأجل تقرير هذا المبدأ العظيم استعظم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اشتكى إليه قبطي مصري من ضرر ناله من قبل ابن والي مصر آنذاك ، وقال قولته المشهورة “ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا “.
فالولاة والحكام لا يملكون سلطة على رعاياهم أكثر مما يبيح لهم الشرع في طاعتهم في المعروف ، فلا يحق لهم الاعتداء على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم مهما كانت الظروف ، أو التحايل على حقوهم مهما كانت المسوغات والمبررات ، وهم خُدم لشعوبهم ، ولأجل عملهم يصرف لهم بيت مال المسلمين ( البنك ) ما يسد حاجتهم وحاجة أسرهم من غير إسراف ولا تقتير .
لم يكن الإسلام يوما من الدهر مصدرا للمغالبة والقهر والاستبداد ومصادرة الرأي المخالف بقوة السلطان ، بل كان ولا يزال يعظم الإنسان ويعلي شأنه ، ويحرم العدوان والظلم ، كما يؤكد أهمية المشورة والمشاركة في تأسيس نظام الحكم وتصحيحه وتقويمه ، ويسمح بمعارضة الحاكم ومخالفته إذا خالف الشرع والهدي الصحيح .
ومن أمعن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في بناء وتأسيس نواة الحكم الإسلامي في المدينة المنورة وما صار عليه الخلفاء الراشدون من بعده يكتشف بلا مواراة بأن سياسية الحكم في ظل الإسلام مبنية على العدل والمساواة ، وأنه لا سادة ولا عبيد في داخله ، ولا يحابي أحدا مما كان موقعه الاجتماعي ، ولا مكان للاستبداد والقهر في نظامه .
وأما الأخطاء والفظائع والمخالفات الشرعية التي ارتكبت بعد انتهاء فترة الخلافة الراشدة وما صاحبها من حكم جَبري حول الحكم إلى مؤسسة عائلية لا يستند إلى نص قرآني أو سنة نبوية بل هي سنة قيصر وكسرى كما قيل إثر حدوث أول بيعة بولي العهد في الإسلام .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الحكم سيخرج عن مساره الصحيح الذي ارتضاه الشارع للأمة وسيتحول إلى ملك عضوض وحكم جبري ، ففي حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. رواه الإمام أحمد في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات.
إذا فأنظمة الحكم التي جاءت بعد انقضاء الخلافة الراشدة وإن وجد فيها صالحون ومصلحون أقاموا أعمالا عظيمة في صالح الأمة إلا أنها لا تمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام في تداول السلطة بل شابها كثير من الأخطاء والمخالفات ، واتسمت بالاستبداد وتنكيل المعارضين لها بصورة فظيعة تقشر لها الأبدان .
وأخيرا فلا علاقة بين الإسلام وبين والاستبداد ، لأن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من أغلال القهر والظلم ، وأما الاستبداد فهو وليد الهوى والسيطرة والاستحواذ طاعة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء .