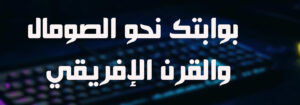بعد صلاة العصر، قام مسرعا يتخطى الرقاب وقف أمام التلاميذ مزمجرا، تعرف في وجهه المنكر، ما إن استدار إليهم حتي خيم المصلى حالة من السكون المرعب! والهدوء المرتقب لتصرف الأستاذ الذي لا يرحم؛ لئلا تفوتهم كلمة من أوامره الصارمه، والتي لا يتجرؤ أحد في مخالفتها أو التفريط في أمرها!
هو في عقده الخامس يحمل عصا غليظة في يمينه، تحسبها راعي الإبل، وفي اليسري كتيبا بدا لي حين رماه علي الأرض بقسوة وبإهمال شديدين أنه مقرر التفسير في أحد الصفوف الثانوية!! جلس أمامهم بعد أن تلى عليهم أوامر صارمة، وحذرهم من التفريط في حقها، ثم قال لهم وهو يحملق نحوهم، يصوب ويدوور بعينيه: استغفروا ربكم! فبدأوا للتو يتمتمون ويهمهمون ويغمغمون! لا أدري بالضبط هل يسبحون ويستغفرون أم يستعيذون بالله من تطاير شرره، ومن أن يصبَّ عليهم جام غضبه؟!
رأيت منهم انضباطا فائقا في حضرته، يتفانون في المسارعة لتنفيذ أوامره؛ اتقاءً من شره وغضبه وعقوبته، أما حين يغيب ويختفي عنهم رأيت الهول والخطب الجسيم، هرج ومرج، سباب شتائم، مصارعة وملاكمة….. فأدركت أن الانصياع لأومره ما كان رغبة وطواعية منهم!
تلك صورة من صور المعلم المتسلط وأثر السيئ على طلبته، فالمعلم حين يتحول إلى مفترس شرس يطارد فريسته، والتي ترتاح في غيبته ويرتاع قلبها حين يسطو عليها حتى يأتي مالكها ليفلتها من قبضته، إنها حالة بالغة الخطورة على مستقبل الناشئة والعملية التعليمية برمتها.
إن تحول مهنة التلعيم إلى وسيلة ارتزاق، وتحول المؤسسات التعليمية إلى محلات تجارية هدفها تحقيق أكبر الأرباح، بدون اهتمام لجودة أركان العملية التعليمية، والتي تمثل المعلم والمتعلم والمنهج والمقرر والبيئة التعليمية والإدارة التي تتولى متابعتها ومراقبتها حتى تحقق الأهداف المنشودة على أكمل وجه؛ إن هذا التحول لمصيبة عظيمة وآفة كبيرة تحتاج منا إلى وقفة صادقة لتصحيح وترشيد مسيرة العملية التعليمية! قبل أن يحدث الأسوأ!
لا أنسى صورة ذلك التلميذ الذي تأذى كثيرا من جراء الضرب المبرح، كل ما هفا وتلعثم في أحد واجباته الدراسية، وكان بطيء الحفظ، كثير اللعب، إن لم يكن بليدا، وكان المعلم لا يراعي الفروق الفردية، وليس في قاموسه شيء كهذا، يضع التلاميذ في خانة واحدة، ما حدا بذلك الطالب كراهة المعلم وكراهة القرآن!! الذي يدرسه حتى صرح بذلك في آخر المطاف!! فتحول إلى المليشيات وأصبح عضوا في مليشيات تابعة لأثيوبيا، حتى كان من ضمن الجيوش الإثيوبية الغازية التي أهلكت الحرث والنسل في فترة 2006 – 2008 ونُقِل عنه: أنه لو رأى ذلك المُحَفِظ لأرداه قتيلا، لأنه يُكِنُّ له البغض والكره الشديد!
قارن بين هذا المعلم وكم أساء إلى مهنة التعليم التي كان ينبغي أن يرتقي بها في أعلى العليين؛ لأنها أشرف المهن إذ هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قارن ببنه وبين ذلك المعلم الذي يتلهف الطلاب شوقا إلى لقياه ووصول ساعة حصته، لينهلوا من معينه العذب، ويرتشفوا قهوته المميزة؛ ذلك الذي ما إن وصلت الساعة التي يدخل على التلاميذ حتى بدأوا يتبادلون التهاني، هم يتخافتون أن الحصة لأستاذ فلان، صاحب الحديث الشيق والطرح الجذاب المنمق، صاحب الدعابة والجدية والتفاني في تبليغ رسالته بألطف أسلوب، وأيسر طريقة؛ لذلك أحبوه فيطيرون فرحا في لقاءه… دخل إلى حجرة الدراسة فحياهم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فضجوا برد السلام بصوت واحد والقلب يخفق من الحب والحنان المتبادل، بعد التحية والتمهيد للدرس بقصة رائعة مأثورة عن قصة عمر بن الخطاب وكيف كان يحب أن يتقن عمله في جميع مراحل حياته وخاصة في فترة ولايته لإمرة المؤمنين، وكم كان يجتهد ليوفر لرعيته أقصى أسباب الرفاهية والعيش الكريم، ومن رعاياه التي شملها عطفه الدواب بحيث روي عنه: أنه لو تعثرت دابة في العراق لخشيت أن يسئلني الله لِمَ لَمْ تُعبِّد لها الطريق!
ثم توجه إلى السبورة وكتب عنوان الدرس الجديد: الإحسان، ثم علق على الجدار ورقة مقواة كتب عليها طائفة من النصوص الواردة في الإحسان وأهمية إتقان العمل، فيقوم بشرحها بأسلوبه الذي يحبونه؛ توضيح وبيان وشرح وقصة ذات علاقة بالموضوع وفكاهة ودعابة لا تنتهي؛ عين جارية بالنسبة لهم لا يملون منها؛ وفوق ذلك أحبوا الابتسامة التي لا تفارق محياه، والبشاشة الدائمة التي تزيدها الأيام رسوخا وثباتا!
علمهم كيف يجب على المسلم أن يكون محسنا في كل حين وآن ومكان؛ محسنا في علاقته مع ربه؛ في عبادته، في صلاته وزكاته وحجه وجهاده، ونسكه وسائر عباداته كلها، وأن يكون محسنا في علاقته مع ذاته؛ في ملبسه ومشربه ومأكله، وتحميلها على مكارم الأخلاق، والارتفاع بها إلى سماء الكرم والجود والسخاء، وتحميلها على المكاره، وإبعادها وفطامها عن المساوئ؛ لتعلو وتسمو؛ فتسعد بذلك في الدارين، وأن يكون المسلم أيضا محسنا في علاقته مع الآخرين؛ نعم الآخرين! الكون كله وما حواه من مخلوقات بث الله فيه؛ ابنا محسنا، أخا محسنا، طالبا محسنا، شابا محسنا، زوجا محسنا، زوجة محسنة، أبا محسنا، موظفا محسنا، معلما محسنا، مهندسا محسنا، مديرا محسنا، طبيبا محسنا، وزيرا محسنا، رئيسا محسنا؛ بكل إيجاز أن يكون الإحسان سمته، زينته، لباسه أينما حلَّ وارتحل، لا يفارقه.
يُدَق الجرس وهم في أوجِّ نشوتهم، فيتمنون لو توقفت الساعة لهم كما توقفت الشمس ليوشع بن نون عليه السلام، ولكنه يفاجؤهم: أحبابي أعزائي الكرام، سنتوقف هنا مادام أن الحصة انتهت، وسنلتقي غدا – إن شاء الله – ونكمل القصة، لكن عندي شرط إذا أردتم أن نكمل القصة، فقالوا: ماهو؟ فقال: أن تحفظوا النصوص الواردة في الدرس، وتُحلوا التمارين بعناية، عندها سنكمل القصة، وأزيدكم بأخرى أروع منها.
فصاحوا صيحة رجل واحد: نفعل .. نفعل يا أستاذ.
هذان نموذجان متقابلان تمام التقابل في الأسلوب والطريقة والشخوص، متضادان في التأثير والتحفيز، متغايران في النتيجة والثمرة، فلا مقارنة بين الحنظل والزيتون…. فيا ليت الذين يتولون أمر المؤسسات التعليمية يحسنون اختيار المعلمين، ويجعلون معيارهم الأكفأ فالأكفأ، لا الأقرب فالأقرب قبيلة أو حزبا، ويا ليت الذين لا يحسنونها يتأخرون ويفسحون المجال لأهلها، ولا يضعوا أنفسهم في أماكن لا تتقنها فذلك إهانة وإذلال لها، ( ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه).