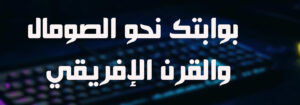مسكت بقلمي، واستجمعت على تسويد الورق، وابتعدت عن الضوضاء والضجة، وانعزلت في مكان هادئ، على خلاف العادة حيث كنت لا أكترث بتهيئة الجو إذا عزمت على الكتابة، لكن هذه المرة استعصت عليّ الأفكار، ولم تنثل عليّ كالمألوف، أطرقت رأسي وسرحت ذهني في سوانح الخيال، وأمعنت التفكير في محطات حياتي وما يمت إليها بصلة، علّني أجد فيها ما يستحوذ على اهتمامي، ولم يسبق لي أن نوهت به في أثناء مقالاتي، وفجأة وبعد أن كاد اليأس يدبّ إليّ تذكرت ذلك اليوم الذى تلبدت السماء فيه بغيوم الحزن، واحتفلت حارتنا بالمأتم، وارتفعت نياحة الجيران، وذرفت الدموع من مآقي أقراني، حتى خطت خطوطا في الخدود، بينما لم تسعفني الجفون على قطرة من الدمع، وإنّ سكب الدمع يخفف لوعة القلب أحيانا، حيث بقيت مندهشا أمام جثة صديق الطفولة، وتجمدت أعضاء جسمي، ولم أقدر أن أنبس ببنت شفة، ولا أن أقدم العزاء لأخيه الذي كان ينتحب في حرقة، امتنع عن تغطية وجهه حتى يكتحل بنظرة محياه النظرة الأخيرة قبل إيداع جسمه في الرمس، فأكبّ عليه بالتقبيل، حتى سحب الحاضرون جسمه بعنوة بعد أن رفض النهوض منه، كان مشهدا حزينا، والذي كاد أن يحز قلبي من الأسى هو طريقة الإغتيال والتي كانت بشعة بمعنى الكلمة، حيث أن العصابة المجرمة، اعتدوا عليه جسديا وأشبعوه بالضرب واللكمة حتى إذا ضعف وارتخت مفاصله، ودبّ إليه الوهن، وتملّكه الوجع، أخذوه في وسط البحر حيث قتلوه بالإغراق، فلفظت البحر مع بزوغ الشمس الجثة، كأنها وديعة تؤديها بكل أمانة، فذهبت يومها بعد التجهيز أجر قدميّ إلى البحر لمناجاته قليلا ومعانقة تلك الأجواء الرائعة حتى يسري عنّي ما حلّ بي من الغم، ورأسي يدوي بصدى ما سمعته من أن سبب موته أن الظنون قد أحاطت به بأن له علاقة حب مع امرأة، جرى بينهما قصة حب مع اختلاف الطبقة، قصة غاية في الغرابة، لكنّي شاهدت مرارا مثل سيناريوهاتها في الأفلام، والذي يدهشني أن القصة نفسها تحيط بها هالة من الغموض عن تعمد كما بدا لي، فلما وصلت إلى مسرح الحدث وجدت المكان خاليا، والطبيعة طاغية باذخة، نسيم الرياح تداعب أغصان الأشجار، والأمواج متلاطمة، كأنها تستشاط غيظا لما جرى، وهناك تسابقت الدموع من محاجرها، كأنها قطيع من المواشي تكاد تموت من الظمأ، فأرسِلًتْ على مورد ماء، بقيتُ هناك طول ذلك اليوم ومن الغريب أنه لم يحضر إلي البحر شخص، كأنما فرض على عشاق الطبيعة حظر التجول في هذه البعقة، تذكرت المرحوم، وزمالتي معه في أول الوهلة، كنا نتشابه في أمور كثيرة منها المزاج والسجية، ومنها الفقر الذي طغى على ملامحنا وأزال منّا الرونق، هو الذي علمنّي مشاهدة الأفلام الهندية التي أصبحتُ مؤخرا من المولعين بها إلى حد الإدمان، من المرتادين لدور السينما، لا أكترث بنصائح إخوتي، هو الذي أعطاني الضوء الأخضر إلى الدخول في عالم التسكع في الشوارع الذي لم يقدر لي بأن أطأ قدمي على أرضيته الرخوة، حيث أنقذني منه أخي الأكبر وأخذني إلى مركز الطريقة الربيعية، حيث تكيفت مع تلك الأجواء الروحانية بسرعة، وانقطعت صلتي به إلا لقاءات عابرة، أبرزها تلك المرة التي صادفنا في الطريق أنا وأخي وكان يلّمع أحذية الناس، ويعمل من كدّ يده وعرق جبينه، فبعد معانقة وتبادل التحية، تفضل أن يلّمع أحذيتنا بالمجان، فرفضت إلا أن أدفع له، آه فقدت صديقا عزيزا زاملني في أهمّ فترات حياتي، وقع في فخ الحب وشراكه المردي، فتمادى على السير في دربه المحدق بالأخطار، فكان الثمن روحه، قكم تحويه القبور من قتيل للحب، ضحّى بنفسه ليخلّد قصة تضاف إلى مئات القصص، كنت أودّ أن أكتب هذه القصة التي أودت بحياة صديقي – فكم من واقع أغرب من خيال – لكنّي أصبت بخيبة أمل لما لم أجد خيوطا ترشدني إلى بداية القصة ونهايتها، فقفلت راجعا إلى بيتي وأنا أدعو له بالغفران والإكتحال برؤيته في الجنان.
أقرأ التالي
أخبار
20 أغسطس، 2017
حركة الشباب تعلن رسميا مقتل علي جبل
أخبار
24 يونيو، 2015
الحكومة تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم في مقديشو
أخبار
29 أكتوبر، 2019
معركة الانتخابات….. صراع البقاء بين الحكومة والمعارضة
أخبار
19 يناير، 2017
حادثة “غلدوغب” هل ستكون بداية تشكّل الوعي الإجتماعيّ؟
أخبار
9 نوفمبر، 2013
تفاصيل الانفجار الذي وقع في فندق مكة المكرمة
29 يونيو، 2016
تنبؤات حول : الانتخابات الرئاسية القادمة في الصومال 2016
20 أغسطس، 2017
حركة الشباب تعلن رسميا مقتل علي جبل
18 أكتوبر، 2017
بالصور..مقديشو تلملم جراحها وتعيد بناء ما هدمه التفجير الانتحاري
24 يونيو، 2015
الحكومة تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم في مقديشو
1 مارس، 2016
أحمد مدوبي يتهم المجتمع الدولي بالتلكؤ عن إعادة تشكيل الجيش
24 مارس، 2018
حليمة إسماعيل: اجتماع بيدوا سيحدد شكل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة
21 يناير، 2016
أوضاع اللغة العربية في الصومال قراءة تاريخية لعوامل الازدهار والانحسار (6)
29 أكتوبر، 2019
معركة الانتخابات….. صراع البقاء بين الحكومة والمعارضة
19 يناير، 2017
حادثة “غلدوغب” هل ستكون بداية تشكّل الوعي الإجتماعيّ؟
9 نوفمبر، 2013
تفاصيل الانفجار الذي وقع في فندق مكة المكرمة
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
دلالات إنخراط “العدل والمساواة” في الجيش السوداني24 مارس، 2024