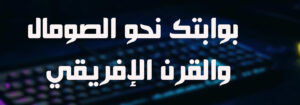“الدّاء العضال يستلزم دواءًا خطرًا”، مقولة تاريخيّة منسوبة لرجل من القرن السّابع عشر، شكّل علامة فارقة في أدبيّات التمرّد، من خلال سعيه لإصابة البنية المستقرّة – والفاسدة – للمجتمع في مقتل، بصورة قد تؤدّي إلى تغيير مفاجئ وسريع في منحى تفكير الجموع، عبر الصّدمة الشّديدة الّتي قد تؤدي إلى حرف اتّجاه تيّاره العام، القائم على مسايرة الوضع الحاليّ والتماهي معه، نحو عكسه المؤديّ إلى البحث عن الأسباب التيّ تمّ عبرها استغلال “غفلة الجماهير”، وأن تكون تلك الصّدمة من القوّة بحيث تتمُّ زلزلة مسلّماتها، ووينتهي شعورها الواثق بأنّ الوضع القائم، سيبقى مستقرًا إلى الأبد!
وقد يكون الموضوع الّذي بين أيدينا، مستحقًا بكلّ جدارة أن نستعيد ذكرى “غاي فاوكس”، الّذي سعى لإثبات وجهة نظره سنة 1605م، عبر محاولته تفجير مبنى البرلمان البريطانيّ، احتجاجًا على الفساد السّياسي الحالِّ في قاعاته وضمن أروقته، بما حوّل الادّعاء بأنّ السّلطة للشّعب، مجرّد بقرة حلوب تدّر على من أخذ صفة “النّائب” أو الممثّل الشّعبي، مكاسب شخصيّة لا تعود سوى بالضّرر والمعاناة على أوساط الشّعب المُمَثَّلِ بهم عامة!
التّخلف الفكريّ فراغ تملؤه الفئويّة
إنّنا لنكون واقعيّين فإنّنا ملزمون باعتبار نظم المحاصصة الفئويّة – القبليّة لدينا -، بديلًا منطقيًا وعمليًا لغياب التبّاين الفكريّ الّذي يقود إلى قيام أحزاب سياسيّة حقيقيّة في البلاد، منذ أن بدأ العمل بتلك المحاصصة إبّان قيام أول دولة قوميّة صوماليّة سنة 1960م، وانتشارها – أي تلك المحاصصة – على مستوى كل الكيانات السياسيّة القائمة في البلاد، سواءًا الانفصاليّة كجمهوريّة صوماليلاند المعلنة من طرف واحد سنة 1991م، أو الولايات بدءًا بونتلاند التي أُعلنت سنة 1998م وصاعدًا، وكلّها دون استثناء لا يعدو منهجُها في تقاسم السّلطة، عن الخضوع لمحصلات تفاوت القوة العسكريّة للقبائل، ونتائج “الغالب” و”المغلوب” في الحدث السياسيّ الأهمّ في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وهو سقوط نظام الجنرال محمد سياد برّي.
لذا سيكون من الأساسيّ لدى مقاربة حالة التّنافس السياسّي الحاصلة، إدراك أنّها باختلاطها بالعامل القبليّ، يمكنها بكلّ سهولة أن تصبّ كرافد حديث لذات النّزعات الاستئصاليّة القديمة، والعُتوِّ العبثيّ المبنيّ على اعتبار “الثّأر الأزليّ” الّذي كان دائمًا الوسيلة الأنجع – عصبيًا -، للرّد على الهزيمة السياسيّة أو العسكريّة أو هيمنة طرف على آخر في مرحلة ما من مراحل التاريخ السياسيّ أو العسكريّ أو القبليّ، ذلك الاعتبار المزمن والعميق الجذور في المجتمع، أصبح وتحت تأثيره لا يمكن أن ينفصل في أذهان العامّة حادث كـ”خسارة مرشّحنا”، عن حادث سابق له بقرون مثل في استيلاء الآخرين – المنتصرين مرّة أخرى – على “قطيع إبلنا” أو “بئرنا” أو “مراعينا”، وعليه تبقى العمليّة السياسيّة المبنيّة على المحاصصة القبلية، أداة لحجب الجمر القبليّ، بطبقة من الرّماد السّياسيّ، الّذي سرعان ما يتبعثر إن هبّت رياح أزمة سيّاسيّة عاتية.
ما المانع إذَا في طرح جذرّي – راديكاليّ – ضدّ الفئويّة القائمة؟
إنّه من المهم عند مقاربة “العصبيّة الفئويّة” – القبليّة لدينا -، إدراك أنه من المستحيل استئصالها، بإحلال “تعصبّات” جديدة، إذ أن التعصّبات الفكريّة أو الغلوّ الدينيّ، لا يمكنه أن يزدهر ويسيطر على الأرض، إلا في ظلّ حالة ضعف المجتمع الّذي تعاني فئاته من نتائج عدم الثّقة المتبادلة التي صنعتها بأيديها، وذلك يكون قائمًا على أن “التعصُّبات” تسعى إلى حجز الواقعين تحت هيمنتها ضمن أطارها، باذلة كلّ الممكن لعمل أشكال متعدّدة من القطيعة مع المحيط – بدءًا من العشائريّ وصولًا إلى الدّوليّ – ، وذلك لا يمكن أن يتيسّر لها، إلّا بوجود حالة من التوجّس بين الفئاتِ الخاضعة لها، وعليه فإن أيّ خطاب نظير لها – ولو شكليًا – في سعيه للقطيعة مع الحاضر الفاسد المبنيّ على الماضي الفئويّ، وإن كان جامعًا وساعيًا إلى الاعتماد على التّمايز الفكريّ، المؤدي للتّمايز في البرامج السياسية، يجعله خطابًا جديدًا مماثلًا أمام “الجموع/الجماهير” للخطاب المتعصّب للغلاة، وهنا يُصاب ذلك الخطاب النّبيل في مقتل.
هُنا ينطرح السّؤال: وما العمل؟ خاصّة أنّ “الجموع/الجماهير” لا ترغب في غير ما اعتادته، وضمنها فئات عالية الصوت دون تأثر حقيقي في مجريات الأمور خارج عن رفضها للتّساؤل حول المقصود، من دفعها نحو “تشغيل العقول”، وكلّ ذلك قبل الوصول إلى مرحلة التّأثير عليها، تلك المرحلة التي ستقود إلى توجّس المستفيدين من الواقع القائم، والذين سيرون أنَّ “التَّوجه الجديد” خطر على ما “استقر عليه الحال” لأجلهم، بعد جهد اقتضى هدر الكثير من الجهد والوقت والمال، وقد يكون مما لن يتسامحوا في هدره، ثمار ما قاموا به من المخاطرة بمصيرهم الأخروي، حسب العقيدة الدينية للمجتمع الذي نشؤوا فيه، لذا ستكون مقاومة تلك الفئة “فئة الواقع المستقرّ” مستميتة، فلا عاقل يقبل أن ينتهي به الحال “بلا دنيا” و ضميره يخبره بأنّه غدى “بلا آخرة”!
مقاربة الهدف المحدد:
إن ما وصلنا إليه من محصّلة، حول وقوع الفئات العالية الصوت ضمن الجماهير أسيرة لعاداتها، من خلال ممانعتها للجدل الفكري، المؤدي لـ”تشغيل العقول”، والمقاومة الشرسة المتوقعة من “فئات الواقع المستقرّ”، تجعلنا نعيد التّفكير مرارًا في الخطوات الواجب اتّخاذها، لتفكيك تلك الحالة التي تميل إلى “التكلّس”، والتي يمكن حلحلتها عبر إذابة الأداة الأساسية بأيدي “فئة الواقع المستقرّ”، والمعتمدة دائمًا وأبدًا على “تقديس أفراد”، بدعوى أن واقعنا “الجيّد” ثمرة لجهودهم سوءًا كان ذلك صحيحًا أو ملفّقًا، ويتسنّى لهم ذلك بنقل الصّراع الفكريّ من نقد الواقع الحاليّ، إلى جدلّية هل اتبّاع أولئك “الأفراد المقدسين” واجبٌّ أم اختياريٌّ!
هنا تظهر عقبتان أساسيّتان جديدتان، تكون أوّلاهما نجاح “فئة الواقع المستقر”، في حشد مريدي “الفرد المقدّس”، ضدّ طرح فكرة اختياريّة الاتِّباع، باعتبار أنّه من الضّروري “الكشف” عن الأسباب الدّاعية للوصول إلى ما تمّ الوصول إليه من نفي قدسيّة الأفراد، ومدارهِ التطبيقيّ في “الاختيارية” التي ستكون من مبتدئها إلى منتهاها قائمة على التّشكيك في “قدسّية” الأفراد محلّ التّقديس، لذا سيُوضع المطالِبون بطيّ صفحة تلك العقيدة “الفئويّة”، إمام تحدٍّ كبير جدًا سيستهلك جزءًا مهمًا من طاقتهم، ناهيك عن أنَّ صمودهم ذاك قد يؤدي إلى جعلهم عرضة، للأذى من قبل المتعصّبين، على مستويات معنويّة أو ماديّة، بالغة في خطورتها حد المساس بسلامتهم الجسديّة!
وحال النَّجاح في ترويض “الجموع/ الجماهير”، عبر إظهار عبثيّة مقاومتها لـ”وجود” فكرة نافية لقدسيّة من يقدّسون، تبدأ العقبة الثانية في التَّبلور، ممثلة في ظهور فصيل من “فئة الواقع المستقرّ”، يستخدم المزايدة على “قدسية السّابقين” في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، أوّلها محاولة إحراج فصائل أخرى من “فئة الواقع المستقرّ” وسحب البساط من تحت أقدامها، وسحق المقاومة الفكريّة لمبدأ “تقديس الأفراد”، عبر “تقريع” الحشود على تخاذلها أمام “المخرّبين/المفكرّين”، وعزو الأمر إلى قلّة همة الفصيل المهيمن على “فئة الواقع المستقرّ”، وكذلك مكر ودهاء المفكرّين المتآمرين، والّذين من الواجب تصفيتهم بقيادة “الفصيل الجديد”، وبذا يتغيّر وجه الفئة المسيطرة، وتشعر “الجموع/الجماهير” بحدوث “تغيير”، مهما كان ذلك التغيير وهميًا وشكليًا.
المآل “رد الفعل النهائيّ”:
حثّ الفصيل الجديد من “فئة الواقع المستقرّ”، للجموع على أخذ تدابير طوعيّة تتسم ب-“الجذريّة/الرّاديكاليّة”، سيحقّق له نجاحًا سريعًا وكاسحًا ومدهشًا، إلّا أنّ مِن أهمّ نائجه أنّه سيجعل أطراف هامشيّة مِن “الجموع/الجماهير” تندفع للتورّط في سلوكيات كانت من المحظورات سابقًا، وهو ما سيسبّب صدمة حقيقيّة لجانب آخر من الأطراف الهامشيّة، بما يولّد حالة من الشّعور بالتأنيب لـ”لضّمير العام” للجموع التي اتّحدت ضدّ خطر “المخرّبين/المفكرّين”، لأنّه تم تجاوز الحدّ الأدنى من القيم العامّة التي هدّدها المخرّبون، بما يحقّق توازنًا سريعًا ناتجٍ عن حالة من التّساؤل حول ما كان يحمله أولئك الذّين عانوا من “فورة المجموع”، من أفكار وأهداف ومسلكهم في إقناع الآخرين بضرورة تحقيقها على أرض الواقع.
وهنا يحدث رد فعل معاكس في اتّجاهه، مؤديٍّ إلى تجريم المتورّطين من الجموع، في التّجاوزات الّتي حدثت على الأرض، وهو ما سيحاول الفصيل المهيمن حديثًا من “فئة الواقع المستقرّ” الاستفادة منه، عبر تبرئه ممّا جرى مثبتًا “نزاهته” بتصفية من خضعوا لبرمجته، مما يفتح المجال واسعًا للأطراف الهامشيّة التي تنبّهت لما جرى، لتقوم بإسقاط تلك الفئة، والقيام بردّ اعتبار “أدبي” لمن لوحق واضّطُهِدَ لأجل فكره ومبدئه، وإن بدى سابقًا في نظر “الجموع/الجماهير” غريبًا ومجهولًا ومخيفًا، وقد تنتقل حالة “ردّ الاعتبار الأدبي” إلى إحاطة أولئك محل ردِّ الاعتبار بهالة من “القدسيّة” الّتي رفضوها منذ البداية، إلّا أنّ المحصلة النهائية لسلوك التّقديسيّ الذي هو من طبيعة “لـ”الجموع/الجماهير” سيؤدّي إلى الارتقاء بالخطاب العامّ، محقّقًا تقدّمًا لم يكن متاحًا في وقت سابقٍ من الأوقات!
محمود محمد حسن عبدي